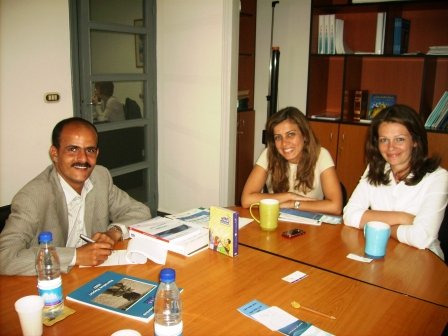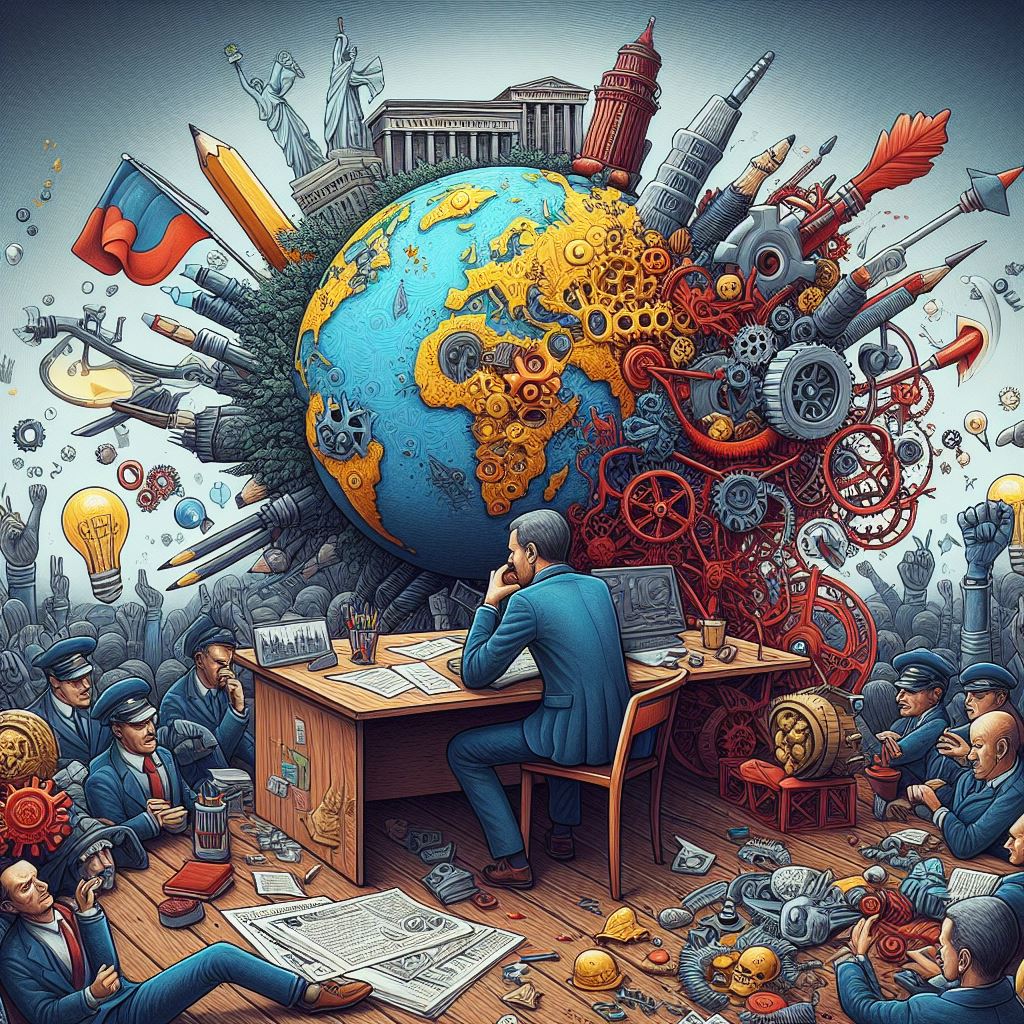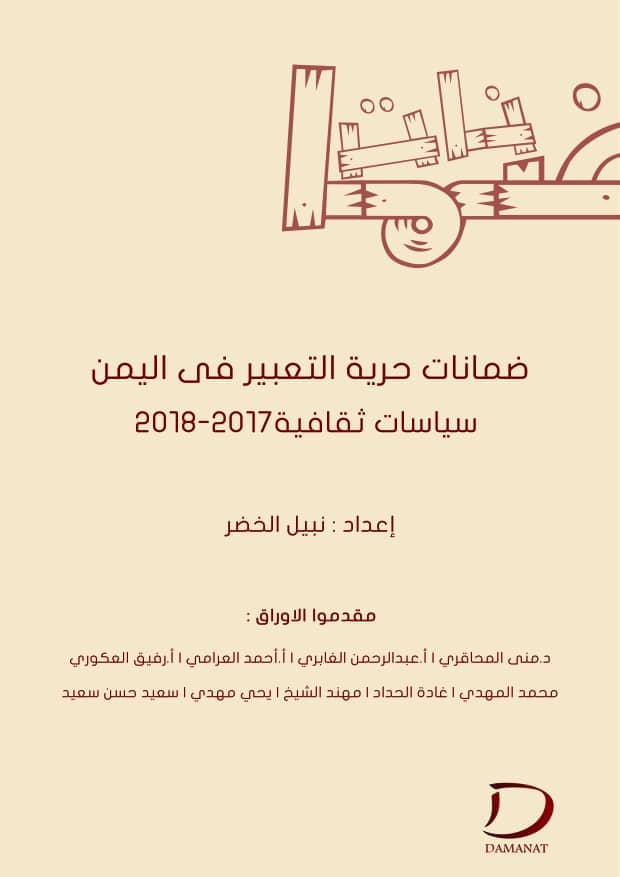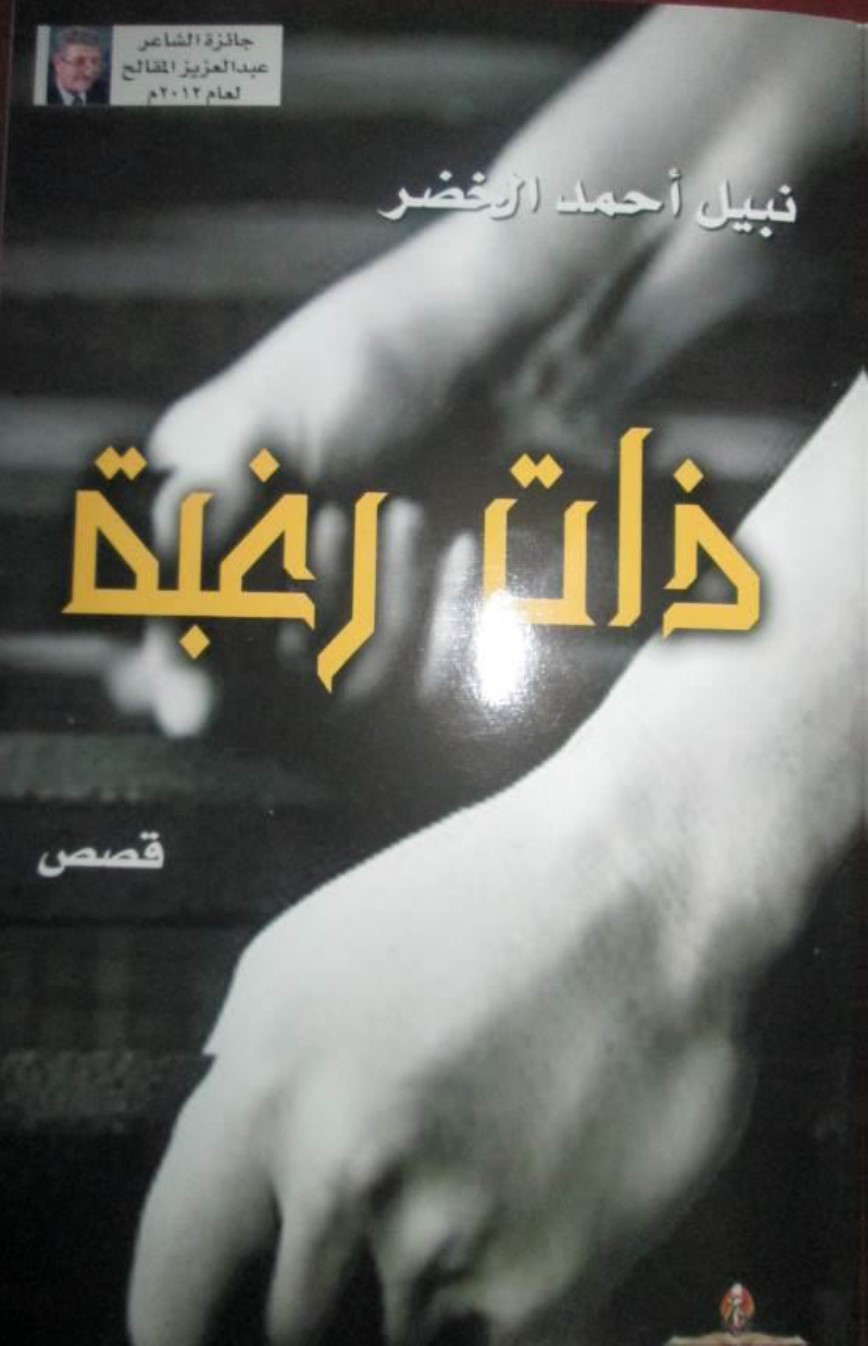Tue,Dec 16 ,2025

أنواع التدخلات الإنسانية العامة- الغذاء إنموذجا
2025-04-25
إن الغذاء الجيد، والوصول إليه، وتوفره بالأسواق، واستطاعة المجتمع المتضرر شراءه عبر موارده، هو أول من يتضرر في الصراع في المجتمعات حيث يسيطر الاحتكار، وغلاء الأسعار، وندرة السلع الغذائية في الأسواق، وما يتتبع الصراع من تأثير على الزراعة كنشاط إنساني يساهم في توفر الغذاء، وتأثير الصراع السلبي لعمليات الاستيراد والتصدير للسلع الغذائية من السوق الدولية، وهذا ما يطرح موضوع الغذاء كأهم التدخلات للمنظمات الإنسانية، والعمل على التعمق في مفهوم الأمن الغذائي، وأنواع المشاريع التي تنفذ فيه، والمشاكل التي تحيط به، وتأثيراته على الفئات الإنسانية، وتعريفاته المختلفة لدى المنظمات ووكالات الأمم المتحدة هو أمر ضروري.
ولنبدأ بتعريف الأمن الغذائي عالميا بحسب الإصدارات الدولية المتخصصة فقد عرفت منظمة الأغذية والزراعة الأمن الغذائي بأنه حالة "يتمتع فيها جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي أغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية لحياة نشطة وصحية"، والعمل على أنشطة الأمن الغذائي في المجتمعات المتضررة يحتاج من المنظمة التي ترغب بالتدخل العمل على:
1. تصميم التدخلات الخاصة به بشكل مناسب، وتطورها مع تطور الصراع في المجتمع.
2. زيادة معرفتها حول قدرة المجتمعات المتضررة على الحصول على الغذاء، وإنتاجه، والإمداد به.
3. تحليل خياراتها في مجال استجابتها، والإجابة على الأسئلة المتعلقة به من قبيل، هل أدى الصراع لانعدام الأمن الغذائي في المجتمع؟، وإلى أي حد بلغ مستوى انعدام الأمن الغذائي من نواحي الوفرة أو الندرة والأسعار وقدرة الفئات الإنسانية على شرائه؟، وهل المشكلة في توفر الغذاء؟ أو القدرة في الوصول إليه؟ أم قدرتهم على استخدامه.
4. وضع خريطة خاصة بالأمن الغذائي في المجتمع المتضرر تشرح ما هي المناطق الأكثر تضررا؟، ومدى قدرة المنظمة على الوصول لهذه المناطق.
5. وضع تصور حول المجموعات السكانية المتضررة، ومن من الفئات الإنسانية هو الأكثر احتياجا من قبيل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع.
6. معرفة مدى خطورة انعدام الأمن الغذائي على حياة الفئات المتضررة؟، وتأثيره على سبل العيش الخاصة بها.
7. معرفة ماهية الاحتياجات التي يمكن للمنظمة تلبيتها؟، والمخاطر التي يمكن أن تهدد المنظمة عند تنفيذها لبرامج الأمن الغذائي.
8. معرفة ما مدى قدرات المجتمع المتضرر على التعامل مع المشكلة؟، وهل هناك مجموعات في المجتمع تشترك في نفس استراتيجيات سبل العيش؟، وكيف كانت حالتها قبل الصراع؟، وما هي مصادر الغذاء التي كانت متوفرة في السابق؟، وكيف اختلفت بعد الصراع؟، وكيف اختلفت المواسم الزراعية التقليدية.
9. معرفة ما هي الممتلكات والأموال التي تمتلكها المجتمعات؟، وطرق استخدامها لتلك الممتلكات؟، وطرق إنفاقها للأموال؟ والمسئول عن الإنفاق؟، ومن المتحكم في موارد الأسر.
10. معرفة ما هو الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني هناك.
11. معرفة مدى سهولة وصول المستفيدين للأسواق القريبة منهم؟، وما هي المسافة بين المجتمع المتضرر وأقرب سوق لهم؟، ودرجة الأمان في التنقل ما بين مجتمعهم المحلي والسوق؟، وهل الطريق سالكة بالنسبة ؟، وهل لديهم قدرة على التنقل بسهولة بين قريتهم وأقرب سوق لها.
12. معرفة ما هي السلع المتوفرة فيه؟، وهل هي كافية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي الغذائية؟، وهل تتناسب مع طبيعتهم الثقافية؟، وقدرتهم على التعامل مع هذه المواد؟، وهل تحتاج للطبخ.
13. معرفة هل لدى المجتمع المحلي الأدوات التي تساعدهم على طبخها؟، وهل تتناسب مع احتياجات الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أم لا.
14. معرفة سابقة لدى المنظمة المهتمة بالعمل الإنساني بنمط الغذاء الذي كان متوفر في المجتمع قبل الدخول في الصراع ؟، وكم كان يمتلك المجتمع من مصادر غذاء محلية وماشية ومستويات الشراء للمواد الغذائية من خارجه في السابق ضمن العمليات التجارية التقليدية في وضع السلام.
15. المقارنة بين الوضع السابق والوضع الحالي وكيف أثر الصراع في المجتمع على مصادر ونوعية وتوفر الغذاء؟، وكيف كان تأثير الصراع على مصادر الدخل الخاصة بهم؟، وكيف كان تأثيره على أنماط الصرف على الغذاء أو المصروفات الأخرى الترفيهية أو الأساسية؟، ومستوى وصولهم إلى الأسواق التي كانوا يتسوقون منها في السابق.
16. معرفة ما هي الاستراتيجيات التي اتخذتها الأسر والمجتمع المتضرر لمواجهة الوقوع في خطر المجاعة أو عدم التوفر الكامل للغذاء، وافتقادهم للأمن الغذائي؟، ففي كثير من الأحيان يكون هناك حلول محلية قام بها المجتمع المتضرر لتقليل أثار الصراع عليهم، وهذا من المواضيع التي تحتاج الدراسة والمعرفة للبناء على هذه الحلول بدلا من العمل من الصفر مع المجتمعات المتضررة.
17. أن تكون المنظمة مدركة بالمعايير الإنسانية الدولية التي تضمن تدخلات إنسانية إيجابية ومؤثرة في مجال الغذاء.
18. أن تعمل المنظمة على بناء استراتيجيات لدعم الأمن الغذائي لهم بما يضمن كرامتهم الإنسانية، وحصولهم على الصحة والحماية التي يحتاجونها.
19. التعرف على الكثير من المعلومات، ولكنها ليست بالأمنية أو بالمعايير الإنسانية، وإنما تلك المعلومات المتعلقة بالغذاء نفسه في المجتمع المتضرر، وما هي نسب استهلاكه وجودته واستدامته وتوفره وقدرة المجتمع على التعامل معه.
20. القيام ببحوث أو الاستفادة من البحوث السابقة التي قامت بها منظمات أخرى حول التغذية في المجتمع المتضرر؟، ومدى تأثيره على صحة النساء والأطفال.
21. معرفة مدى تواجد مراكز الأمومة والطفولة ومراكز التغذية في المجتمع.
22. إدراك المخاطر الخاصة بسوء التغذية في المجتمع وأثرها على الصحة العامة؟، وهل توجد أي علامات مجتمعية لتفشي حالات سوء التغذية للأطفال؟، أو تفشي الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للمجتمع بشكل عام.
23. إدراك ماهية التدخلات التي يجب على المنظمة القيام بها لتخليص المجتمع المتضرر من النزاع من سوء التغذية؟، وحالات الوفاة الناتجة عن سوء التغذية أو انعدامها في المجتمع؟، وهل سوء التغذية ناتج عن الفقر أو الهجرة أو النزوح أو اللجوء؟، أو بسبب الصراع المتفشي في المجتمع.
24. التعرف على ممارسات الغذاء الخاصة بالأطفال في المجتمع؟، وخصوصا الرضع منهم؟، ودرجة انتشار الرضاعة الطبيعية في المجتمع؟، وهل يحتاج الأطفال أنواع إضافية من المواد الغذائية التي تحتاجها أجسادهم كونهم في مرحلة التكوين الجسدي.
25. معرفة هل هناك تدخلات من منظمات إنسانية أخرى لتلبية الاحتياج الخاص بالأطفال ؟، أم أن هناك حلول مجتمعية يمكن البناء عليها وتشجيعها واستثمارها.
26. العمل على إيجاد إجابات حول أوضاع العمل، والعمليات التجارية، ونشاط المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيه، والمنشآت التجارية الخاصة، وهل ما زالت تواصل عملها أم أنها توقفت عن العمل.
27. التعرف على المؤسسات الرسمية والمجتمعية التي يمكنها من خلالها الوصول للفئات المستهدفة من قبيل وزارة الصحة، والمجالس المحلية، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والقيادات المجتمعية، وغير ذلك من المؤسسات التي يمكن أن تساعد في نجاح العملية الإنسانية التي تستهدف المجتمع.
28. التعرف من خلالهم على الوضع الغذائي الذي كان متوفرا قبل الصراع، وعلى قدراتهم في تشجيع المبادرات المحلية لرفع مستوى الأمن الغذائي في المجتمع، ومشاركتهم في تصميم المشروع الخاص برفع مستوى الأمن الغذائي؟، وأفكارهم عن التدخل وحجمه الذي يمكن للمنظمة الإنسانية أن توفره.
29. توفير المساعدات الغذائية للمجتمعات المتضررة بحسب المعايير الدولية، والتي تتمركز أولها حول مدى توافر الغذاء في المجتمع المتضرر، والناتج عن الإنتاج المحلي، والواردات الغذائية والمساعدات الغذائية، وثاني هذه المعايير حول موضوع الوصول إلى الغذاء نفسه، وقدرة الأسر والمجتمعات المتضررة على الحصول عليه بانتظام، وثالثها المتعلق بجودة المواد الغذائية وتلبيتها لحاجات الأسر والمجتمعات المتضررة بكل فئاتها الإنسانية المختلفة.
30. معرفة الثقافة المحلية أو الدينية أو المجتمعية التي تضر بالأمن الغذائي الخاص بها، وتوعية هذه المجتمعات بتطبيق الممارسات الجيدة.
وتنتشر هذه الممارسات حتى في مرحلة الصراع، ووقوعها ضمن فئة الاحتياج الملح للغذاء، ومن ضمن هذه الممارسات المتعلقة برعاية الأطفال وخصوصا في مرحلة الرضاعة أو في السنتان الأولى من عمر الطفل، وتلك المتعلقة بالغذاء الخاص بالنساء الحوامل أو في مرحلة الولادة، والتي لا تحتوي على ما يحتاجه الطفل أو الأم في هذه الفترة الحرجة من عمريهما من أغذية، وكذا بعض الممارسات الصحية التقليدية التي تؤثر على صحة الطفل أو الأم كختان الإناث، والتوجه إلى الطب الشعبي بما يحتوي من ممارسات غير صحية، وقد تتجه هذه الفئات المجتمعية لمثل هذه الحلول الضارة بسبب سوء الخدمة الصحية التي تقدمها الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات العاملة في المجتمع، وبالتالي يمكن للمنظمة الراغبة بالعمل في المجتمع المتضرر العمل على:
1. تطوير البنية التحتية الصحية في المجتمع، والممارسات الصحية التقليدية الإيجابية قبل العمل على التدخل الإنساني المرتبط بالأمن الغذائي.
2. فهم شمولي لكل ما يحيط بالمجتمع من درجة حدة الصراع ؟، وقدرة المجتمعات على مواجهة قلة الأمن الغذائي ؟، والقدرة على الوصول إليهم.
3. معرفة المؤسسات التي ما زالت تعمل لديهم؟، وأصول المجتمع المتضرر الذي تتيح لهم مواجهة انعدام أو قلة الأمن الغذائي لديهم؟، وماهية السلطات التي تتحكم بهم.
4. معرفة الفرص التي يمتلكها المجتمع للقفز على عقبة الأمن الغذائي.
5. معرفة حالات الضعف الشديد لديهم.
6. معرفة الممارسات الفضلى حول إشراكهم في العملية الإنسانية في مجتمعهم.
7. التعرف على الصراع المحيط بهم؟، وحدوده؟، وتداعياته؟، وأسبابه؟، ونتائجه؟، ودرجة تضرر المجتمع منه؟، وكيف استطاعوا مواجهته عبر حلول مجتمعية قاموا بها.
8. معرفة الفجوات في موضوع الأمن الغذائي الذي يمكن للمنظمة ردمها للوصول إلى أمن غذائي مناسب.
9. تحليل الاحتياجات والوضع السائد في المجتمع.
10. معرفة ما هي البنية التحتية الرسمية وغير الرسمية التي تساعد في نجاح العملية الإنسانية.
11. معرفة المجتمع المتضرر والعمل على معرفة احتياجاتهم الملحة؟، وقدراته.
12. معرفة الفرص الأمنية والجغرافية والسياسية التي تمكن المنظمة من العمل.
13. التعرف على مصادر الغذاء للأسر في المجتمع المتضرر؟، وما هي الخطط التي يقومون بها للحصول على الغذاء.
14. معرفة مدى تواجد الثروة وأصحاب النفوذ في المجتمع.
15. معرفة الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل فيه؟، وما هو الوضع الغذائي قبل الصراع وأثناء.
16. إدراك الأدوار المجتمعية للنساء والرجال فيه.
17. إدراك أماكن الضعف في المجتمع والتي يحتمل أن يكون لها دور في توفر أو انعدام الأمن الغذائي.
18. معرفة الاختلافات الثقافية والمجتمعية داخل الأسر أو المجتمع حول تفضيلاتها الغذائية.
19. معرفة الخيارات لدى المنظمة بخصوص الاستجابة للأمن الغذائي؟، ونوعية تدخلاتها؟، وأنشطتها؟، وخياراتها العملية؟، وطرق توزيع الغذاء؟، والعمالة التي تحتاجها العملية الإنسانية لتوزيع الغذاء.
20. وجود معلومات حول التدخلات الأخرى من منظمات أخرى أو من المجتمع نفسه.
21. معرفة كيفية التعامل مع حماية الأطفال في هذا التدخل.
22. معرفة اعتبارات النوع الاجتماعي التي تتقيد بها المنظمة.
23. معرفة أطر التنفيذ الفعال؟، وطرق المراقبة لسير العملية الإنسانية بسهولة في المجتمع.
24. تصميم أنشطة تقييم التدخل لحل مشكلات المجتمعات والحرص على عدم الوقوع فيها في أي استجابة إنسانية قادمة فالعمل الإنساني ككل.
25. تعزيز التأثير الإيجابي، وتقليل الأخطاء الناتجة عن قلة التجربة، أو صعوبة العمل في المجتمع المحلي، أو بسبب الأوضاع الأمنية أو السياسية التي قد تشكل عقبة أمام النجاح الكامل للعملية الإنسانية للمنظمة العاملة في المجتمع.
26. عدم الركون لتصميم إنساني واحد للعمل في المجتمعات المتضررة، وهذا لا ينجح حتى مع الإيمان بجودة هذا التصميم ونجاحه في مجتمعات أخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك تصميم يناسب كل مجتمع على حدة ناتج عن فهم ظروفه الفريدة.
ومن الأخطاء الشائعة في أنشطة الاستجابة الإنسانية:
1. الركون أن الوصول لنتيجة جيدة في الأمن الغذائي في المجتمعات سيقوم على حل المشكلات الإنسانية الأخرى الناتجة عن الصراع ولكن هناك الكثير من المشكلات الصحية والتعليمية والأمنية والثقافية التي لا ترتبط حلولها بتوفر الغذاء الكافي.
2. التدخل دون تحليل لوضع الصراع والمجتمع، وهل من الأجود تقديم المساعدات له بشكلها العيني أو عبر النقد لمساعدتهم على شراء ما يحتاجونه من السوق المحلي.
3. التدخل دون معرفة ما هي نتائج كل تدخل من هذه التدخلات.
4. الفساد وإساءة استخدام السلطة سواء بشكلها المجتمعي عبر القيادات المجتمعية، والمؤسسات الحكومية، أو بشكلها الأسري ومساهمتها في العنف المبني على النوع الاجتماعي.
5. عدم إدراك المنظمة أنها لا تستطيع العمل وحيدة.
ويجب على المنظمة لتفادي الوقوع في الأخطاء:
1. العمل مع المنظمات الأخرى والسلطات المحلية والمجتمعات المتضررة بشكل شبكي فاعل وإيجابي.
2. الحصول على المشورة والدعم من كل الشركاء في داخل المجتمع وعلى المستوى الوطني والدولي بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والوكالات التنموية والإنسانية.
3. معرفة أن التدخل الجيد في مجال الأمن الغذائي ليس فقط من يرفع مستواه في المجتمعات المتضررة إلى مرحلة الكفاية، ولكن الذي يشمل المعونة الغذائية، والتحويلات النقدية، وبناء المجتمعات المحلية الزراعية.
4. العمل على تطوير قدرات المجتمع للتغلب على حالات قلة أو انعدام الأمن الغذائي في المستقبل، وتطوير سبل المعيشة، وتعزيز مرونة المجتمعات في التعامل مع الصدمات المستقبلية المشابهة، وتسهم في علاجها بشكل إيجابي ومستدام.
5. تطوير استراتيجيات استيراد المواد الغذائية أو شراؤها محليا، وبناء قدرات القطاع الخاص، وتطوير الأسواق المحلية وقدرتها على تقديم الخدمة الخاصة بتوفر المواد الغذائية بشكل جيد.
6. العمل على تمكين الأسر من الوصول لهذه الأسواق، والحصول على الغذاء الخاص بهم بما يتناسب مع قدراتهم الشرائية وتفضيلاتهم الغذائية بالإضافة لأنشطة ومشاريع تساعد المجتمع على استعادة قدرته على إنتاج الغذاء، وسيطرته على الأصول الخاصة به.
7. العمل على خلق بيئة سوقية تنافسية وخدمية تحفز الإنتاج وزيادة الطلب على السلع، والعمل على التوزيع المباشر للمساعدات الغذائية للأسر المتضررة.
8. الاهتمام بحالات سوء التغذية، وخصوصا للأطفال، وعلاج الحالات الحادة منها.
9. الترويج للممارسات الصحية الجيدة بالغذاء للنساء والأطفال، وتشجيع الاهتمام بالثروة الحيوانية وصحتها، والممارسات الزراعية الجيدة وتطبيقاتها، وتوزيع المواد والأدوات التي تساهم على تنشيط المجتمع على إنتاج الغذاء كالبذور والأسمدة للمزارعين، وشباك ومعدات الصيد للصيادين.
10. بناء قدرات المجتمعات بما يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي لها.
لقد تطورت أساليب ومشاريع وأنشطة الأمن الغذائي، وتنوعت ما بين الأمن الغذائي عبر التوزيع المباشر للمواد الغذائية للمتضررين، ومن بعدها المساعدات عبر التحويلات النقدية غير المشروطة والخاصة بالدعم المالي للأسر لشراء مستلزماتها الغذائية من الأسواق المحلية، لتأتي بعدها برامج النقد مقابل العمل والتي تقوم على تشغيل المستفيدين في تطوير وصيانة أصولهم المجتمعية كالمدارس والطرق والآبار وغيرها في مقابل مبالغ مادية تعود نفعها لزيادة الأمن الغذائي للأسر المشاركة، والتي لا تسهم في الضرر بالسوق المحلي، وتعمل على صيانة الأصول المجتمعية التي يمكن للمجتمع الاستفادة منها في حياته، ويوفر بناء قدرات و مهارات جديدة تساعدهم في الدخول في العمالة المحلية أو الوطنية، وحصولهم على فرص عمل بعد انتهاء الصراع, وإن هذه الإيجابيات ليست كل شيء في التدخل الإنساني، ومن المهم الإشارة لبعض المشاريع التي يمكن أن تدعمها المنظمة المتدخلة في العمل الإنساني والتي يمكنها أن توفر الدخل أيضا للأسر مثل:
1. أنشطة الغذاء مقابل التدريب للرجال في المجالات التي يستطيعون العمل فيها كالتجارة، والطلاء، وطرق العمارة، وصيانة الأدوات الإلكترونية، وللنساء في مجال الخياطة، والتطريز، وصناعة المعجنات، والكوافير، وصناعة ثياب الأطفال، وطرق التجميل وتجهيز العرائس.
2. تصميم المشاريع التي يمكن للمستفيدين الحصول عبرها على مشروع مستدام و مدر للدخل.
وتحتاج المجتمعات المتضررة لتحرك عاجل لتلبية احتياجاتها، وكل هذا العمل يحتاج لـ:
1. سرعة اتخاذ القرار من المنظمة المعنية بالتدخل.
2. بيانات صحيحة وموثوقة وسريعة.
3. استراتيجيات للتدخل بشكل سريع ناتج عن تحليل متماسك للوضع على الأرض.
4. مشاركة الوكالات الأخرى في الوقت المناسب لتصميم التدخلات المشتركة، ونوعية كل تدخل، ومخاطرة، كتوزيع المواد الغذائية، أو النقد المباشر، أو النقد مقابل العمل، أو غيرها من البرامج.
5. معرفة قدرة الأسواق على التكيف، ومساعدتها، ومراقبتها، ومراقبة الوضع الخاص بالأمن الغذائي عن قرب في المجتمع.
6. الخروج بتقييم شامل وجيد لتأثير الاستجابة الإنسانية، ويشتمل على:
✔ نتائج التدخل، وإحصائيات حول الفئات الإنسانية المستفيدة وفئاتها العمرية، ونوعها الجنسي، وظروفها الخاصة من الإعاقة، والطبقة الاجتماعية.
✔ معدلات ارتفاع الصحة، ارتفاع أعداد الوفيات.
✔ تواجد أنظمة مراقبة وتقييم فاعلة تعطي مؤشرات جيدة عن العمل الإنساني، وتأثيره في المجتمع.
✔ كيفية معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في المجتمع، ووصولهم المتساوي للمساعدة في الأمن الغذائي.
✔ العمل بشكل تكاملي في جميع أنشطة الاستجابة الإنسانية لتستطيع المنظمات التي تعمل في المجتمع الخروج منه وقد ساهمت في تطوره ومرونته وصحته العامة.