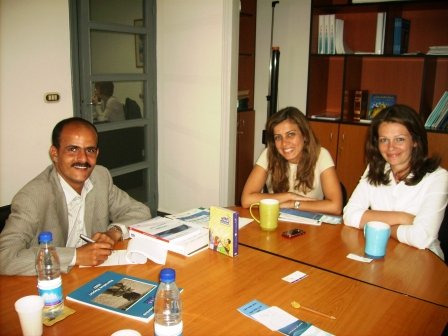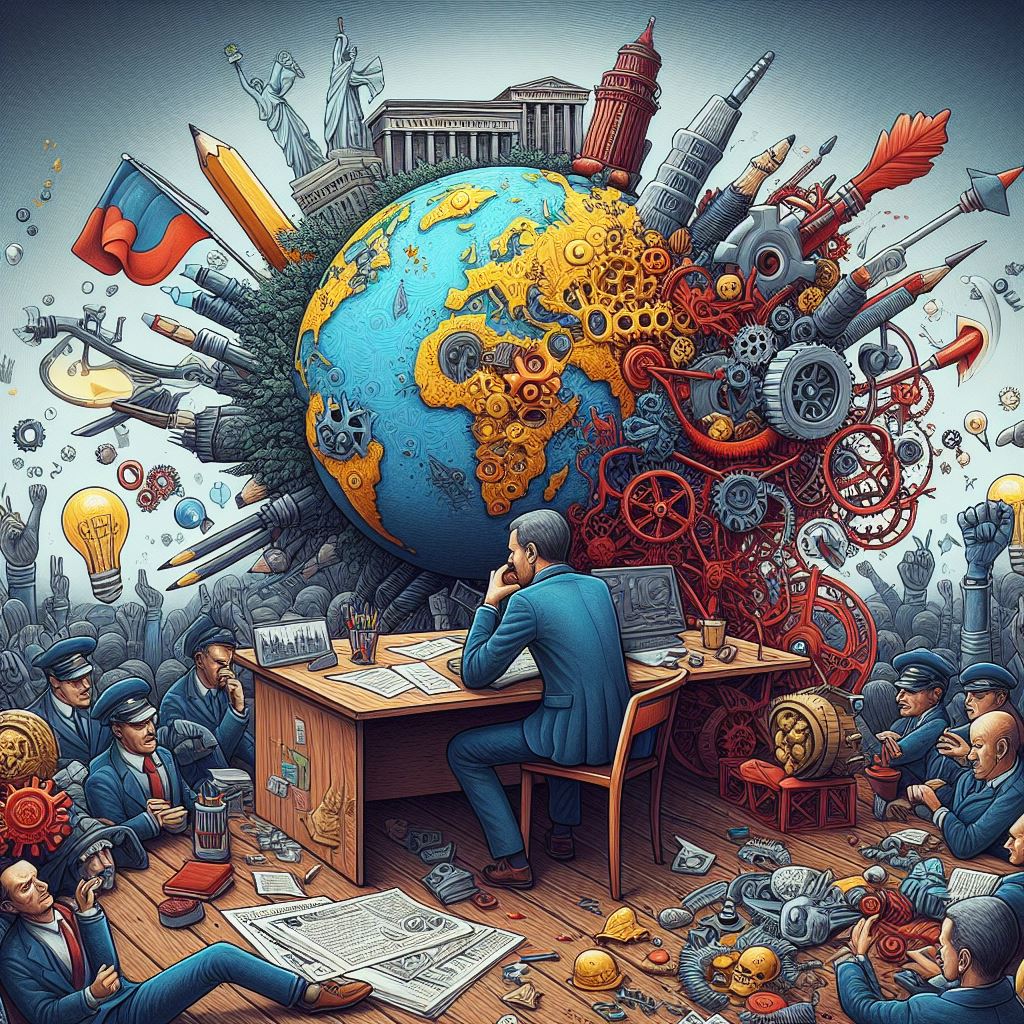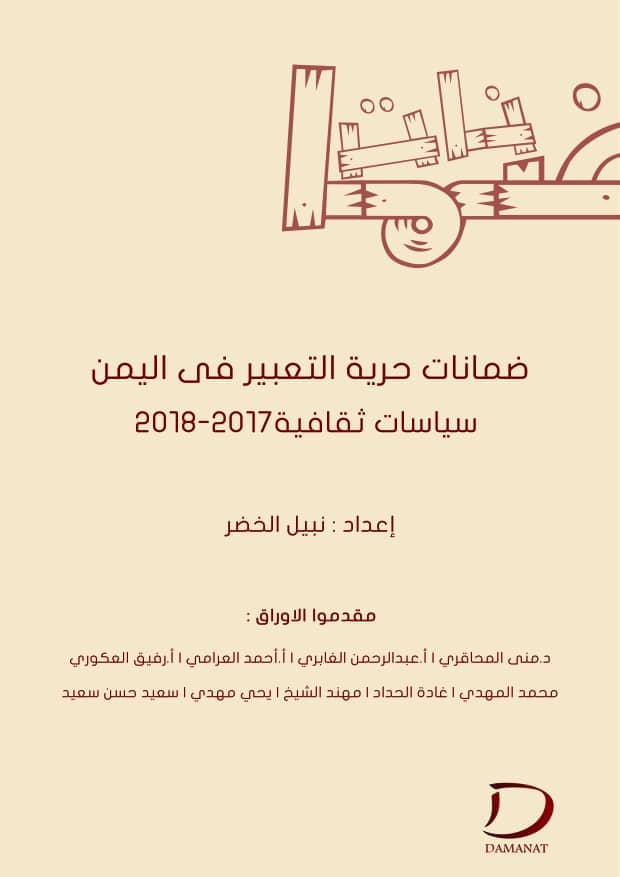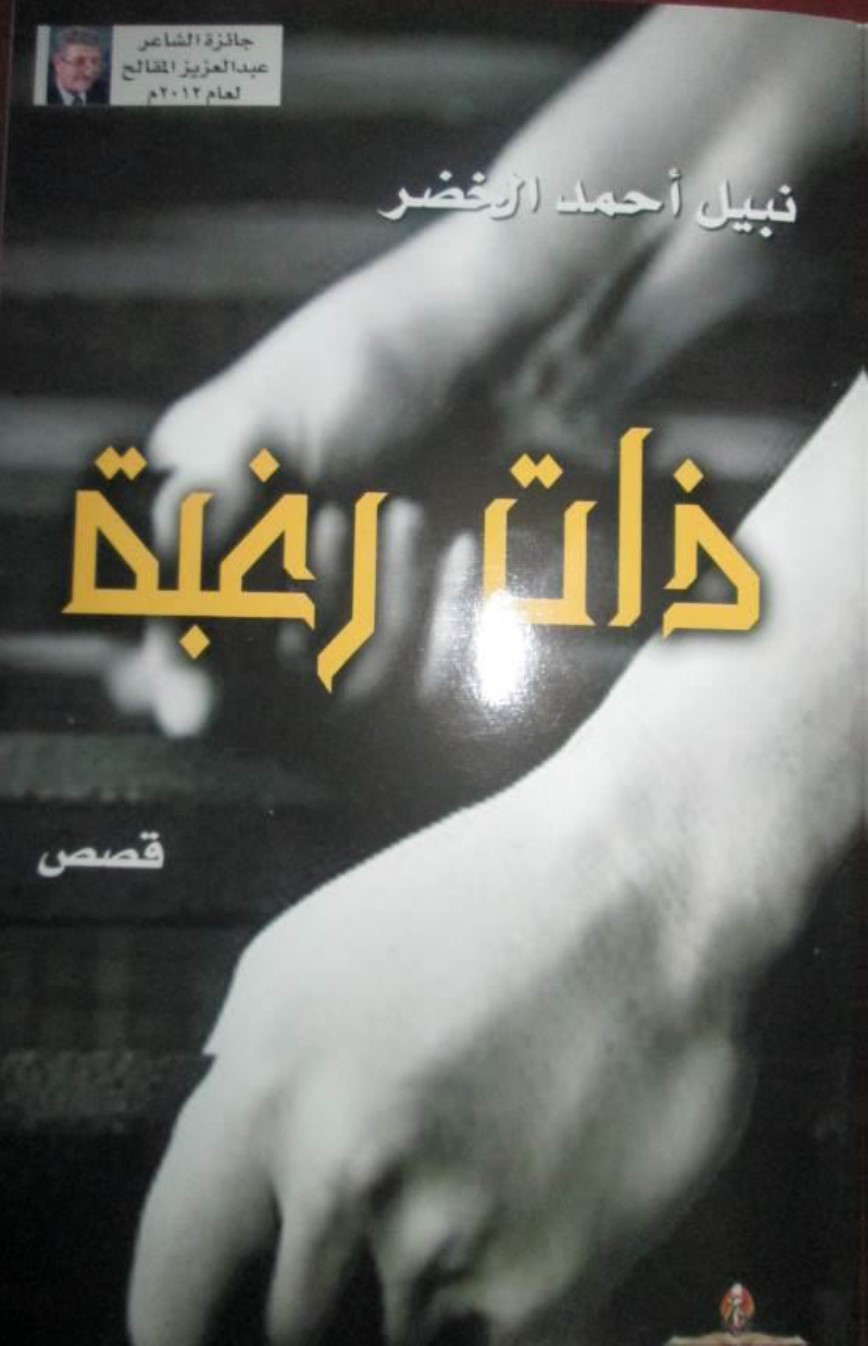Mon,Dec 15 ,2025

التعليم في دول الصراعات بحسب الشبكة الدولية للتعليم في الصراعات
2025-04-25
أول هذه الأبواب المتعلقة الدنيا بالتعليم في الطوارئ، والمتعلق بالمشاركة والذي يهتم بمشاركة أعضاء المجتمع المحلي بنشاط، وشفافية، ودون تمييز في التحليل، والتخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والرصد، والتقييم للاستجابات التعليمية، بينما يهتم المعيار الثاني المهتم بالموارد بتحديد موارد المجتمع، وتعبئتها، واستخدامها لتنفيذ فرص التعلم المناسبة، ويهتم المعيار الثالث بالتنسيق في مجال التعليم، وتدعم أصحاب المصلحة الذين يعملون على ضمان الحصول على التعليم الجيد واستمراريته، ومن ثم ندخل لمعايير التحليل، ويهتم المعيار الأول من هذا الباب بالتقييم، وتجرى تقييمات التعليم في الوقت المناسب لحالة الطوارئ بطريقة شاملة، وشفافة، وتشاركيه.
ويختص الباب الثاني باستراتيجيات الاستجابة، وتشمل استراتيجيات الاستجابة للتعليم الشامل وصفا واضحا للسياق، والحواجز التي تعترض الحق في التعليم، واستراتيجيات للتغلب على تلك الحواجز، ويهتم المعيار الثالث بالرصد، ويجري الرصد المنتظم لأنشطة الاستجابة التعليمية، والاحتياجات التعليمية المتطورة للسكان المتضررين، ويهتم المعيار الرابع بالتقييم، وطيف تؤدي التقييمات المنهجية والنزيهة إلى تحسين أنشطة الاستجابة للتعليم وتعزيز المساءلة.
وفي الباب المتعلق بالوصول وبيئة التعليم فهناك عدد من المعايير أولها الخاص بالمساواة في الوصول لجميع الأفراد، ولديهم فرص الحصول على التعليم الجيد وذات الصلة، والثاني المختص بالحماية والرفاهة بيئات التعلم آمنة وآمنة، وتعزز الرفاهة النفسي والاجتماعي للمتعلمين والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم، والمعيار الثالث المختص بالمرافق والخدمات، وكيف تعزز مرافق التعليم سلامة ورفاه المتعلمين والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم، وترتبط بخدمات الصحة والتغذية والنفسية الاجتماعية والحماية.
وكذا في الباب المتعلق بالتعليم فهناك عدد من المعايير ويختص الأول منها بالمناهج الدراسية، وتستخدم المناهج الدراسية ذات الصلة ثقافيا واجتماعيا ولغويا لتوفير التعليم الرسمي وغير الرسمي بما يتلاءم مع السياق، والاحتياجات الخاصة للمتعلمين، والثاني الخاص بالتدريب والتطوير المهني والدعم، وتلقى المعلمون وغيرهم من العاملين في التعليم تدريبا دوريا، وملائما، ومنظما وفقا للاحتياجات والظروف، والمعيار الثالث الخاص بالتدريس، وعمليات التعلم، وتتميز عمليات التعليم والتعلم بأنها تركز على المتعلم وبيئة التعليم وأن تكون تشاركيه وشاملة، والمعيار الخاص بتقييم مخرجات التعلم وتستخدم الطرق المناسبة لتقييم نتائج التعلم.
ويركز الباب الرابع، والمتعلق بالمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم، وينص المعيار الأول منه بالتوظيف، والاختيار، وتوظيف عدد كاف من المعلمين المؤهلين تأهيلا مناسبا، وغيرهم من العاملين في مجال التعليم من خلال عملية تشاركيه وشفافة تستند لمعايير اختيار تعكس التنوع والإنصاف، ويهتم المعيار الثاني بشروط العمل، ويحدد المعلمون، وموظفو التعليم الآخرون شروط العمل، وتعرض لهم التعويض المناسب، ويختص المعيار الرابع بالدعم والإشراف، وتعمل آليات الدعم والإشراف للمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم على نحو فعال.
ويهتم الباب الخامس من المعايير الخاصة بالتعليم في الطوارئ بسياسة التعليم والذي يختص المعيار الأول منها بصياغة القوانين والسياسات، وتعطي السلطات التعليمية الأولوية لاستمرارية التعليم الجيد واستعادته، بما في ذلك الوصول المجاني والشامل للتعليم، ويختص المعيار الثاني بالتخطيط، والتنفيذ، ومراعاة أنشطة التعليم السياسات، والقوانين، والخطط التعليمية الدولية والوطنية، واحتياجات التعلم للسكان المتضررين.
إن التعليم في الطوارئ يتطلب من المنظمة الراغبة بالتدخل في المجتمع المتضرر العمل على تخطيط الاستجابة له في الطوارئ، والتعرف على المكونات الفنية للتعليم في هذه الحالات، واليات التنسيق بين المنظمات أو القطاعات المتهمة بالتعليم في الطوارئ، وما هي الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية المتوفرة للعمل في مجال الاستجابة للتعليم في الطوارئ بما في ذلك إمدادات التعليم وتوفر الخدمات اللوجستية وأماكن التعليم المؤقتة والمراكز الصديقة للأطفال؟، وإمكانيات تدريب وبناء قدرات المعلمين وموظفي التعليم في الطوارئ؟، والعمل على إعادة المجتمع لاستئناف التعليم الرسمي بعد انتهاء الصراع، وحالة الطوارئ بالإضافة لتقييم العمل وتطويره تبعا لهذا التقييم في المستقبل بالإضافة للتركيز على الخدمات الإضافية ضمن التعليم في الطوارئ كالدعم النفسي والصحي للأطفال المتعلمين، وتوفير المناهج الدراسية، ودور التعليم في التخفيف من حدة النزاعات، وتنمية الطفولة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز، والعمل على الترويج للديمقراطية، والحريات الخاصة والعامة، وحقوق الإنسان والتنمية.
إن الاهتمام بالتعليم في مراحل الصراع قد لا يكون بنفس الزخم الذي يكون عليه في مراحل السلام، وبالتالي يمكن للمنظمة العاملة في مجال التعليم تنفيذ حملات تروج للعودة الى المدارس، والقيام بمشاريع لتحفيز الأسر على مشاركة أبنائهم في العملية التعليمية، والربط ما بين مكون من مكونات الاستجابة الإنسانية مثل الأمن الغذائي والتعليم لتساهم في عودة الأطفال للتعليم من خلال برامج مثل النقد مقابل التعليم والذي ظهرت كتجربة ناجحة في بعض الدول بالإضافة لتوفير وجبات غذائية للأطفال ضمن المراكز الصديقة الخاصة به لتحفيزه وتحفيز أسرته على مشاركته، والحصول على التعليم، والتدريب، وخدمات الرفاة النفسي والجسدي.
وفي حالة مثل اليمن لا يستلم المعلمين رواتبهم منذ 2015 بسبب الحرب يمكن للمنظمة المهتمة بالتعليم في المجتمع المحلي العمل على دفع رواتب المعلمين ليكونوا قادرين على الاستمرار في العملية التعليمية، وكذا تدريبهم على الممارسات الفضلى للتعليم في الطوارئ، وبناء قدراتهم في بعض المناهج التدريبية التي يمكنها أن تساعد الأطفال على الصمود، مثل المهارات المتعلقة ببناء السلام، والمهارات الحياتية، والمتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز الصحة والنظافة الصحية، والممارسات الجيدة، والمعايير العالمية الخاصة بحماية الأطفال في فترات الصراع أو حمايتهم ضمن الاستجابة الإنسانية وتلك الخاصة بحماية الأطفال من العنف، والإساءة، والإهمال، والاستغلال الجسدي أو الجنسي والاتجار، ومشاركتهم في النزاعات المسلحة، وعمالة الأطفال، وأطفال الشارع.
إن معايير إيني الخاصة بالتعليم في مرحلة الطوارئ هي المعايير الأهم، والاشمل، والأكثر تخصصا، ولديها العديد من الكتب، والأبحاث، والدراسات، والمعايير، والأطر، والممارسات، والأدوات، والتقارير، حول التعليم في الطوارئ، ومن المهم لأي منظمة ترغب بالتدخل الإنساني في المجتمعات المتضررة أن تستوعب كل هذه المعايير عند تخطيطها للتدخل الإنساني في مجال التعليم، وأن يكون هدفها تطبيق الحق في التعليم في حالات الطوارئ، وأن يكون التعليم ذو جودة عالية، ويتميز بالأمان والاستدامة، ومستلهما لتجارب المنظمات العاملة في نفس المجتمع المتضرر أو في مجتمعات أخرى تمر بنفس الظروف الإنسانية.
ومن المهم مشاركة الطلاب، وأولياء الأمور والمعلمون، والقيادات المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية في مناقشات مركزة لتحديد المجالات ذات الأولوية في التدخل، كإعادة تأهيل المدارس، والحصول على التعليم والتعلم، وتوفر المياه والصرف الصحي، والفصول الدراسية، مع أهمية مشاركة النساء في كل تلك العمليات الخاصة بالتدخل لضمان تعليم الفتاة في مرحلة الصراع، والحفاظ على وتيرة التنسيق، والتنفيذ، والاستدامة للتعليم في مرحلة الصراع، والاهتمام بتقييم العملية التعليمية ككل بداية من استراتيجيات التدخل، ومروا بالتنفيذ، وليس انتهاء بالخروج من المجتمع المتضرر وانتهاء الاستجابة الإنسانية في مجال التعليم، وإن مساعدة المجتمعات المتضررة لترتيب أولوياتها، وإدراج التعليم ضمن أول هذه الأولويات من خلال ربطه بالأنشطة الأخرى في الاستجابة الإنسانية هو أمر مهم فالأطفال والشباب من أهم الفئات الإنسانية في المجتمع المتضرر التي تحتاج التعافي السريع من أثار الصراع لما لهم من دور في أعمال وأنشطة ما بعد الصراع الذي يعيشون فيه هم وأسرهم.
والتدخل في مجال التعليم يحتاج نفس الجهود التي تحتاجها التدخلات الإنسانية الأخرى فهو يبدأ بتحديد الاحتياجات، ومن ثم التخطيط للتدخل وتلبيتها للحفاظ على استمرارية التعليم وجودته، ومن ثم القيام بالتنفيذ بالتعاون والشراكة مع المنظمات الأخرى العاملة، والشراكة والمشاركة مع المجتمع نفسه، والقيام بمراقبة سير العملية التعليمية وجودتها، والذي يقود في النهاية لتقييم التدخل الإنساني في المجتمع المتضرر من الصراع الذي يخلق العديد من الأمراض النفسية والجسدية والاجتماعية للأطفال، والتي تحتاج التدخل لمعالجتها ضمن أو خارج البيئة التعليمية.
ويجب على المنظمة العاملة في هذا الجانب أن تكون على شراكة مع المؤسسات الحكومية التي ما زالت تعمل في المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية، والقيادات المحلية بما فيها القيادات القبلية أو الاجتماعية أو الدينية للعمل على تخفيف أثار الصراع على الأطفال، ومن التجارب الجيدة التي عايشتها، وعملت فيها، أنني أدرت أكثر من ثلاث مساحات صديقة للطفل خلال الفترة 2015- 2018، والتي أعتبرها من الأفكار الجيدة في مجالات التعليم وخصوصا الانشطة اللاصفية.
إن هناك الكثير من هذه المساحات في مدن اليمن، وتقوم بتلبية احتياجات الأطفال النفسية، والصحية، والمهارية، والتعليمية، وقد عملت المنظمات المهتمة بهذا التدخل على توفير هذه المساحات، واحتياجاتها من اللوازم التعليمية، وجوانب السلامة، والحماية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، وأدوات اللعب، وبناء قدرات الأطفال في المهارات الحياتية، وبعض الأدوات الثقافية كمسرح الدمى، والرسم، والكتابة الإبداعية.
إن المنظمة الراغبة بالتدخل في مجال التعليم في الطوارئ، وإنشاء وإدارة مساحة صديقة للطفل يجب أن تقوم بـ:
1- العمل على فهم الغرض من إنشاءها.
2- معرفة الفوائد التي يمكن للأطفال الحصول عليها من خلالها.
3- دورها في التنشئة الاجتماعية، والعاطفية، والجسدية، والصحية للأطفال.
4- معرفة أين يمكن لهذه المنظمة التدخل؟، وكيف يمكنها ذلك؟، ومتى يكون تدخلها ذو فائدة أكبر.
5- القدرة على التخطيط للأنشطة بشكل جاد وشمولي ومستدام.
6- التنسيق مع سلطات التعليم المحلية والوطنية والمجتمع، والعمل على تنفيذ العمل ضمن هذه المساحة الصديقة.
7- العمل مع الأطفال وتلبية احتياجاتهم بالإضافة للشراكة مع المؤسسات العاملة في مجال المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وقطاعات التعليم.
8- العمل على استخدام الموارد المحلية بما فيها العمالة من المدرسين والمختصين الاجتماعيين، وتلبية احتياجات الأطفال المستفيدين بشكل كامل وشامل.
9- العمل أن تكون الأنشطة أو البنية التحتية لهذه المساحات ملائمة للأطفال واحتياجاتهم، ولثقافة المجتمع وأولوياته.
10- العمل على التعليم كجزء من العملية الإنسانية يجب أن يتجه للأنشطة التي تمكن المجتمع والمتعلمين من مواصلة التعليم ضمن بيئة أمنة تتوفر فيها الخدمات الأخرى كالمياه، والصرف الصحي، وأنشطة الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
11- العمل على أن تسهم هذه المساحات إيجابيا في نفوس الأطفال وخلق الوضع الطبيعي لهم.
12- تعمل على دعم التواصل بين المتعلمين والمعلمين والمجتمعات المتضررة.
13- تلتزم بالمعايير الدنيا في مواضيع التعليم في الصراعات.
14- تحتوي على البنية التحتية الأساسية اللازمة لنجاح هذا التدخل، وإمكانية الاتفاق مع المجتمع المحلي بتجنيب المساحة الصديقة للطفل الصراعات الدائرة في المجتمع.
15- أن تكون المساحة الصديقة للأطفال بعيدة عن المخاطر البيئية كالغبار والرياح، والألغام الأرضية.
16- أن تكون صديقة للأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الديانة أو وضع الأبوين أو الإعاقة.
17- قادرة على توفير اللوازم التي يحتاجها الأطفال في المركز.
18- برمجة الأنشطة بشكل يتواءم مع احتياجاتهم.
19- تلتزم بالمبادئ الدولية في حماية الأطفال في الطوارئ أو ضمن الاستجابة الإنسانية، والمعايير التي تنظم سير عمل المساحات الصديقة للطفل.
20- بيئة أمنة، وقادرة على تقديم خدمة حقيقية للأطفال المتضررين.
21- تفعيل مشاركة الأطفال والمجتمع في تخطيط، واختيار الأنشطة والتصميم لجميع أنشطة المساحات الصديقة للطفل.
22- أماكنها مختارة بعناية لتصبح مساحات صديقة للطفل.
23- التعرف على احتياجات الفئات الخاصة من المتعلمين كالفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من الطبقات الهشة في المجتمع.
24- التعرف على التحديات التي يمكن أن تواجهها عن التنفيذ لهذا النوع من التدخل.
25- وجود دراسة إمكانية وجود مقاومة مجتمعية، وكيفية تخطيها، وصنع قبول مجتمعي للعمل مع الأطفال وتعليمهم.
إن الصراع له دور كبير في صناعة عوامل خطر على المجتمعات ومن ضمنهم الأطفال، ويؤدي لتهديد صحتهم، ورفاهتهم النفسي والصحي والاجتماعي، وتدهور الهياكل المؤسسية التي كانت تقدم لهم التعليم في الماضي، وبالتالي فمن المهم العمل على:
1- إعادة الحياة الطبيعية للأطفال ضمن هذه المساحات.
2- تجنيبهم الآثار السلبية للصراع عبر هذه المساحات أو المؤسسات التعليمية والصحية الشريكة أو المجتمع والأهل والأصدقاء المحيطين بهم، والمعلمين، ومقدمي خدمة التعليم في حالات الطوارئ كالمنظمة الدولية النشطة في المجتمع، أو منظمات المجتمع المدني، أو سلطات التعليم.
3- دعم الرفاهية النفسية والاجتماعية للأطفال.
4- يعالج المشاكل المحيطة بهم.
5- يناهض التمييز الحاصل على بعضهم، وخصوصا من ينتمي في الأصل لفئة اجتماعية تعرضت وما زالت تتعرض للتمييز أو التهميش أو الاضطهاد السياسي أو الاجتماعي في المجتمع.
6- يقلل من حالات انفصال الأطفال عن أسرهم.
7- يقلل من نسب التمييز عليهم بسبب هذا الانفصال.
8- لا يسهم في تدمير الهياكل التي كانت تقدم لهم الحماية والرعاية وتقدم لأسرهم سبل العيش.
9- يعزز حصول الأطفال أو أسرهم على المساعدة الإنسانية، وتقليل الشعور بالظلم والانفصال عن المجتمع.
10- يقلل من شيوع الفساد في العملية الإنسانية، والتي قد تستثني بعض الأطفال من الطبقات الاجتماعية الدنيا والغير قادرة على الحصول على المعونة الإنسانية.
11- يسهم في معالجة للاضطرابات الصحية والنفسية، وزيادة الحزن، والشعور بالضيق، والاكتئاب، والخوف لدي الأطفال اللذين يعيشون في الصراع.
12- يقلل من ظروف الحياة المتغيرة بحسب زيادة أو انخفاض حدة الصراع، وبعد الأطفال عن ممارسة حياتهم الاعتيادية التي تعودوها.
13- يقلل من دور الصراع بالنسبة للفتيات واللواتي قد يتعرضن لتمييز أكبر وأعنف، ويقعن تحت أخطار أكبر في مرحلة الصراع بسبب نوعهن الجنسي.
إن هناك بعض ردود الأفعال لدى الأطفال في الصراع يفترض التنبه لها، والعمل على معالجتها عند العمل معهم في المساحات الصديقة للطفل كـ:
1- قلة نشاطه عن المعتاد.
2- عدم تفاعله مع محيطه الأسري والاجتماعي.
3- أن يصبح عدوانيا أو متمردا أو عنيفا في تعامله.
4- تغيرات في بنيته الجسدية والفكرية، وعواطفه وسلوكياته المعتادة.
5- زيادة حالات الارتباك وصعوبة التركيز، وعدم القدرة في الثقة بالآخرين، وصعوبات في التكيف.
6- مشاكل في النوم والأنانية والإرهاق المستمر، والتي قد تظهر على الأطفال في مرحلة الصراع
إن هذه المشاكل تعتبر فرصة للعاملين في المساحة الصديقة للأطفال وللمنظمة للتعرف على:
1- كيفية التعامل مع الأطفال في هذه المراحل.
2- التعرف على عوامل الصدمة التي أصابته، ومدى كثافتها، وتواترها، وحجم الضغوطات التي تعرض لها.
3- التعرف على العوامل التي أثرت على صحته النفسية، وخلفية الطفل الشخصية، وعائلته، وتاريخه مع العنف، ودرجة تقبله للصراع.
4- معرفة مدى مرونة الطفل هو أو مقدمي الرعاية له في التكيف مع الصراع.
5- معرفة قدرة الطفل وأسرته على الصمود في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.
6- العمل لمعالجة كل المشاكل التي تحيط به، ودفعه لاتخاذ خطوات إيجابية لحلها.
7- دفع الطفل لتحمل المسئولية، واحترام الذات والآخرين، وتنمية قدرته على اللعب والمشاركة.
8- التفاعل مع مقدمي الرعاية له كالأب والأم والأسرة، ومقدمي الرعاية له في المساحة الصديقة للطفل، والذين يقومون بحمايته من الوقوع في الخطر، ويهتمون ببناء قدراته في التعامل مع محيطه، وتلبية احتياجاته للرعاية، والتعليم، والشعور بالانتماء، والنظافة الشخصية، والتحفيز الفكري، والقدرة على المشاركة، والتعبير، والعودة إلى الحياة الطبيعية.
إن هذه المرحلة من حياة الطفل تستدعي ليس فقط تدخل المنظمة الراغبة بالعمل في المجتمع، ولكنها تستدعي تدخل جميع مؤسسات المجتمع الدولية والمحلية للتدخل لما فيه صالح الطفل، وبالتالي فالتعليم أو المساحة الصديقة للطفل خطوة مهمة، ولكنها ليست كل الخطوات، فالأسرة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطات لها دور مهم في:
1- تفعيل استراتيجيات التكيف للأطفال.
2- التقليل من الشعور بالضغط، وعدم الأمان.
3- العمل على تقديم الثقافة المجتمعية الإيجابية للطفل.
4- غرس القيم الإيجابية فيه ليكون أكثر قوة على تحمل أخطار الصراع من حوله.
5- تعزيز دور المجتمع في صناعة مساحات محمية للأطفال، ومناهضته مشاركة الأطفال في الصراع، وزيادة الأمن في المحيط الخاص بالأطفال في المجتمع المتضرر.
6- تعزيز حصول الأطفال على الخدمات التي يحتاجها لنموه ورعايته بشكل إيجابي.
7- المساهمة مع المجتمع في الحفاظ على الرفاهة النفسي والاجتماعي للأطفال.
8- دعم لم الشمل للأسر.
9- المساعدة في الترويج للسلام، وطرق التأقلم مع الصراع.
10- تنشيط برامج في حقوق الطفل ورعايته للأهل والمجتمع.
11- دعم الأنشطة التعليمية الصفية واللاصفية.
12- مساعدة الأسر على سبل كسب العيش لصالح الأطفال.
13- تبني تفعيل الشبكات الاجتماعية الداعمة للطفل، والعمل بالشراكة مع الأطباء والمتخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وكذا العمل مع أخصائيين الصحة النفسية والجسدية.
14- دعم العملية التعليمية لتصبح معززة للصحة النفسية والاجتماعية، وتقدم لهم الأمان، والعلم، والمهارات الحياتية من خلال أنشطة المساحة الصديقة للطفل.
15- تضمين الترفيه، والثقافة، والرياضة، والتعليم لبناء أطفال قادرين على التعامل مع الصراع.
16- الاهتمام بأعمار الأطفال، وحاجة كل فئة عمرية لنوع مختلف من الأنشطة.
17- الاهتمام بجنس الأطفال وحاجة الفتيات لمزيد من الخدمات عن تلك التي يحتاجها الذكور.
18- أن تكون ببيئة التعلم أمنه وتعزز الحماية، وتدرس السياق الثقافي للبلد.
19- أن تكون مرتبطة بالمبادئ والمعايير الدولية التي تنظم الأنشطة والمشاريع.
20- تصمم أنشطة متنوعة بحسب عمر كل طفل من الأطفال المستفيدين، وجنسه، وخلفيته الاجتماعية والثقافية، وإعاقته إن وجدت، وحجم التعرض للصراع، وتأثيره.
21- تلبية حاجة كل طفل لدرجة من الاهتمام والتي تختلف عن الآخرين.
22- مراقبة حالة كل طفل، وتطور حالته النفسية والصحية سلبية أو إيجابية، ودور النشاط في هذه الأعراض واختفائها أو زيادتها.
23- العمل أن تكون بيئة التعلم قادرة على إعادة الحياة الطبيعية للأطفال المشاركين فيها، ومساعدتهم على العيش في سلام.
24- تهدف لاستعادة الروتين، وطرق الحياة المألوفة للأطفال.
25- أن تكون البيئة التعليمية والمواد الخاصة بها مراعية لظروف الطفل الحالية، وتقدم له الاحتياجات المعرفية والمهارية التي تجعله قادر على مواجهة أثار الصراع بشكل جيد.
26- أن تكون المواد التعليمية والبنية التحتية للمساحة الصديقة للطفل مناسبة للطفل واحتياجاته الحالية والمستقبلية.
27- العمل على مقارنة المواد التعليمية التي كان يستفيد منها الطفل ما قبل الصراع، وما يحتاجه الطفل في وقت الصراع من معلومات ومهارات مختلفة.
28- معرفة مدى اختلاف هيكل التعليم ما قبل وبعد الصراع، واختلاف رؤية سلطات التعليم والتعلم في المجتمع المتضرر للتعليم ومفرداته ومناهجه قبل وأثناء الصراع، ورغبتهم باختلاف المنهج، ومدى ارتباط هذا الاختلاف مع حاجات الطفل والمعايير الدولية فقد تكون سلطات الصراع الحالية هي حالة من التدهور السياسي والاجتماعي عن السلطات السابقة.
ويجب على المنظمة الراغبة بالتدخل لسد احتياجات الطفل في مرحلة الصراع عدم الانجرار لمناهج قد تطور من التبعية، والاستغلال، وكراهية حقوق الإنسان، والدعوة إلى الكراهية والعنف والحض عليهما كما حدث في حالات معينة من الصراعات وخصوصا في البلدان التي دخلت صراعات عنيفة بعد ما يسمى بالربيع العربي، ومن المواضيع التي قد تعزز من الروتين الخاص بالأطفال في مرحلة الصراع، وتساعدهم على الإحساس ببيئتهم المعتادة، يمكن للمنظمة العاملة الإجابة على تساؤلات عديدة من قبيل:
1- هل تجربة الطفل التعليمية الحالية تشبه التجربة التعليمية قبل الصراع؟
2- وا مدى توفر المنهج الدراسي السابق وملائمته لأهداف المنظمة والمجتمع المتضرر؟
3- هل المعلمين متوفرين للعمل التعليمي أم أنهم أصبحوا جزء من الصراع أو نزحوا أو قاموا باللجوء إلى دول أخرى؟
4- ما مدى رغبتهم بالعمل في المساق التعليمي حاليا؟
5- ماهي درجة الأمان المتعلقة بهم وبالأطفال في البيئة التعليمية؟
6- هل هناك إمكانيات لإدماج مناهج مستقلة تهتم بالمهارات الحياتية وحقوق الإنسان وبناء السلام؟
7- ما هي درجة الموافقة والتفاعل من قبل السلطات التعليمية لمثل هذه المناهج ومفرداتها وارتباطها بسياسة السلطات التعليمية في المجتمع المتضرر.
إن المنهج وتفصيلاته قد تكون أو لا تكون متوافقة مع السلطات التعليمية الحالية وبالتالي قد لا تنجح المنظمة العاملة التدخل بسهولة في الاستجابة للتعليم، ويجب عليها أن تدرس تفاصيل تدخلها في الجانب التعليمي في المجتمع، وهناك الكثير من المفردات التعليمية التي قد تكون متوافقة أو غير متوافقة مع السلطات التعليمية في وقت الصراع، ونقول السلطات هنا بصيغة الجمع لأن الصراع قد ينتج مجموعة من المجتمعات والمساحات الجغرافية التي قد لا تكون بالضرورة تابعة لسلطة تعليمية أو سياسية واحدة بحسب تطورات الصراع، وامتلاك بعض الطوائف المتحاربة جزء من البلد الذي يمر بمرحلة الصراع السياسي والحربي، وبالتالي يجب على المنظمة العاملة في هذا الجانب دراسة:
1- مدى نجاحها في إدماج بعض هذه المفردات التعليمية في المساحات الصديقة للطفل التابعة لهذه أو تلك من السلطات.
2- العمل على التفاوض بشأنها وأهميتها للطفل في المساحة الصديقة له، ومن هذه المفردات التي قد تحتاج لتفاوض بشأنها هي تلك المواضيع المتعلقة بالمهارات الحياتية، والمواضيع المتعلقة بالسلام وبناء السلام، والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الخاصة والأساسية، والمشاركة المدنية، وطرق التعامل مع الصراع، وتلك التي تستخدم الأدوات الثقافية مثل الأدب، والموسيقى، والمسرح، ومسرح الدمى، والدراما، والتعبير الفني والإبداعي، وبقية الأدوات الثقافية والفنية.
3- معرفة المناهج الغير مرغوبة لدى السلطات الدينية في المجتمع، مع أهمية الإشارة أن بعض أو كل السلطات ذات المنشأ الديني غالبا ما تكون رافضة لمواضيع المساحات المشتركة بين الذكور والإناث، والمواضيع المتعلقة بالمساواة بينهما، والمواضيع ذات الصبغة الجنسية أو التي تهتم بالتثقيف الجنسي والصحة الإنجابية، والتوعية بالأمراض المنقولة جنسيا، وكل ما يتعلق بالجنس من قريب أو من بعيد كما كل السلطات الدينية فيمن البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات وخصوصا العربية والإسلامية.
4- تعزيز قدرة المنظمة على إدماج بعض المفاهيم، والمعلومات، والمعايير، والمناهج الدولية في المساحات الصديقة للطفل كالنظافة، والصرف الصحي، والتعامل مع الألغام، وبعض أنواع الرياضة البدنية، وتعليم اللغات، ومهارات الحاسوب، والمهارات المهنية، ومهارات البقاء على قيد الحياة، وإجراءات السلامة، والمهارات البيئية والتنموية، ومهارات المرونة والشعور بالانتماء، ومحو الأمية، والتاريخ والجغرافيا والحساب والقراءة والكتابة.
5- معرفة المناهج التي قد لا تتوافق مع السلطات التي تسيطر على المجتمع تبعا لطريقة تدريسها، ومن يقدمها، وعلى أي كيفية تصل المعلومات للأطفال.
6- بالعمل في هذه الجوانب المحايدة أن تركز على تفاصيلها، ومفرداتها لتستطيع الوصول للأطفال، والعمل معهم، والقفز على عقبة السلطات التعليمية والسياسية التي تسيطر على المجتمع، والعمل على تصميم منهج وتدخلات تعليمية ومهارية تجعلها على الأقل قريبة من الأطفال، واحتياجاتهم، والتفاوض بشأن بعض المواضيع أو الأدوات المرفوضة لحين النجاح في إدماجها للطفل في المساحة الصديقة الخاصة به.
إن كل هذه التساؤلات أو المخاوف من العمل في مجال الاستجابة للتعليم في المجتمع المتضرر هي بدايات للعمل الناجح للمنظمة الراغبة في العمل، وما يجعل المنظمة منتبهة للغاية حول تدخلاتها هي قدرتها على الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- هل تناسب الأنشطة غرضها وأهدافها كمنظمة.
2- هل تتوافق مع المعايير والأخلاق والسياسات الدولية.
3- هل تتوافق مع احتياجات وثقافة المجتمع والمستهدف منها.
4- هل هي ملبية لاحتياجات الأطفال المستفيدين بكافة أعمارهم وأنواعهم وجنسهم، وفئاتهم الاجتماعية.
5- هل المنظمة قادرة على إدارتها وتفعيلها.
6- هل توفر للمعلمين في مجال تدخلاتها.
7- هل توفر المواد التعليمية التي تلبي شكل ونوعية تدخلاتها.
8- ماهي تفاصيل هذه التدخلات التعليمية أو المهارية.
9- ما مدى تقبل السلطات التعليمية الحالية لها.
10- ما هي خبرات الشركاء العاملين في نفس المجال وفي نفس المنطقة؟، والعقبات التي واجهوها؟، وكيف نجحوا في أعمالهم.
11- ماهي خبرات الشركاء من المجتمع المحلي نفسه كالقطاع الخاص العامل في مجال التعليم.
12- ما هي خبرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية التي تنشط في نفس التدخل الذي تقوم به المنظمة في المجتمع.
13- ما مدى توفر المعلمين أصلا في المنطقة المتضررة؟، ورغبتهم بالعمل مجددا في العملية التعليمية؟، وهل عددهم كاف لحاجات العملية التعليمية التي تديرها المنظمة، أم أن هناك حاجة إلى المزيد.
14- هل يجب أن يخضع المعلمين الراغبين بالعودة العملية التعليمية لتدريب في بعض المناهج أو التطبيقات التدريبية أو الدراسية التي ستقوم المنظمة بإدخالها في مناهج التعليم في مرحلة الطوارئ أو في المراكز الصديقة للطفل أم لا.
15- ما مدى الحاجة لأخصائيين اجتماعيين في بيئة التعليم الحالية.
16- كيف تنظر السلطة التعليمية أو السياسية الحالية للمعلمين السابقين؟، ودرجة موافقتها على رجوعهم للعملية التعليمية، وكيف ينظر المجتمع لعودة المعلمين التابعين لسلطات سابقة للعمل في المجتمع الذي قد يدين بالولاء للسلطة الحالية ويؤمن بمفرداتها.
17- ما هي درجة ارتباط المنظمة العاملة في مجال التعليم بهذه الأفكار التابعة للسلطات أو المجتمعات.
18- ما هي درجة ارتباط هذه التساؤلات بالمعايير والأنظمة الخاصة بالتعليم في الصراعات والتي توافق المجتمع الدولي على أهميتها في أي تدخل للتعليم في أي مجتمع متضرر من الصراعات في العالم.
19- ما هي طرق التعليم وسياساته وأدواته المناسبة للتدخل.
20- وما هي التعويضات التي سيحصل عليها المعلمين وبناء القدرات الذي يجب أن يتمتعوا به.
21- هل تشجع السلطات التعليمية هذه الأنشطة الموجهة لهم أم لا.
22- ما هي درجة تدخل السلطة التعليمية في تصميم خطط التوظيف وبناء القدرات الخاصة بهم ليشاركوا بفعالية في العملية التعليمية في المجتمع.
23- هل المعلمين من المجتمع نفسه أم نازحون؟، وفي حال كانوا من المعلمين النازحين فما هي درجة قبول السلطات التعليمية والمجتمع المضيف لهم ولأفكارهم.
24- هل لديهم الخبرات العملية للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال أم لا؟، وماهية الحوافز المقدمة لهم؟، والأعداد الذي تحتاجهم المنظمة في تدخلها.
25- هل هناك حاجة لمعلمات من النساء؟، وكمية المتوفر من القوة التدريسية النسوية في المجتمع؟، وكم عدد الإناث المستفيدات من التدخل.
26- ماهي درجة توافق المجتمع مع عمل النساء؟، ومعرفة موافقة المجتمع لتدريس الذكور الفتيات المستفيدات من التدخل الإنساني التعليمي الذي تقوم به المنظمة في المجتمع المتضرر، وما هي درجة السيطرة على مدخلات ومخرجات التعليم ما بين المنظمة والمجتمع والسلطات.
27- هل أثبتت مراقبة عملية التعليم أن المدرسين العاملين في العملية التعليمية مؤهلين للتدخل ويملكون الخبرات اللازمة للنجاح.
28- ما هي الأساليب التي يستخدمونها؟، وهل هي بحاجة للتطوير ؟، وهل يحتاجون للتدريب في المجالات التي أثبتت المراقبة لهم أنهم يعانون من القصور فيها؟، ومتى وأين يمكن تدريبهم.
29- هل من الممكن أن يتم بناء قدراتهم عبر ورش العمل أم أنه وبسبب الصراع يمكن الاكتفاء بالتدريب عن بعد.
30- ما هي الأساليب التي يمكن للمنظمة بها تحسين مهاراتهم في العملية التعليمية ككل.
31- ما هي الأساليب التي يمكن للمنظمة بها رفع عملية الجودة في تقديم الخدمة التعليمية للأطفال في المجتمع.
32- كم من الوقت والموارد يحتاجها هذا المساق من بناء القدرات لهم؟، وهل تمتع هؤلاء المعلمين أو غيرهم من المتوفرين في المجتمع لبناء قدرات في التعليم في مرحلة الطوارئ من قبل السلطات التعليمية أو منظمات أخرى من قبل أم لا.
33- ما هي الحوافز أو التعويضات التي يمكن تقديمه لهم لتحفيزهم على العمل بشكل جيد؟، وما مدى حاجتهم الى الدعم وقدرة المنظمة على تقديمه لهم في الوقت والمكان المناسب.
34- ما هي طرق التعاون ما بين المنظمة والمعلمين والمجتمع، وسلطات التعليم لتقديم خدمة تعليمية متميزة للأطفال المتضررين.
35- هل يتم تعزيز دور الأسرة عبر مجالس الآباء والأمهات في المدارس، وتفعيل دورهم في العملية التعليمية في الطوارئ.
36- هل تتم مشاركة الاسر في كل العملية التعليمية بما في ذلك بيئة التعليم وبنيته التحتية والمناهج والمعلمين.
37- هل يتم يمكن دعمهم في مجالات تدفعهم لتبني دخول أطفالهم العملية التعليمية من خلال إدماجهم في مشاريع الأمن الغذائي من جهة عبر منظمات شريكة تعمل في المنطقة التي تعمل فيها المنظمة العاملة في مجال التعليم.
38- هل يتم تقديم حوافز لهم لدفع الأطفال للعملية التعليمية كالتغذية المدرسية، وبرامج رعاية للطفولة المبكرة في المساحات الصديقة تدفع الأهل للعمل بأمان، وتحفزهم على إدماج أبنائهم في خطة الاستجابة التعليمية في مجتمعهم.
39- هل يتم بناء قدراتهم في لاهتمام بصحة الأطفال يعتبر من المحفزات الجيدة للأهل لدفع أبنائهم للتعليم ويمكن للمنظمة العاملة في هذا الجانب ليس فقط التواصل والتفاهم مع السلطات التعليمية في المجتمع، ولكن التواصل والاتفاق مع السلطات الصحية للتدخل الصحي الخاص بالأطفال المستفيدين من العملية التعليمية.
40- كيف تسهم هذه البيئة التعليمية من ناحية البنية التحتية، والجو العام للتعليم، والأداء إيجابيا في تنمية الأطفال في المجتمع المتضرر من الصراع.
41- هل تشمل البيئة التي نتحدث عنها السياسات التي تنظم العمل بداخل المساحة الصديقة للطفل كسياسات منع التنمر أو السياسات الخاصة بالتحرش الجنسي، أو المتعلقة بعدم جواز العنف ضد الأطفال في العملية التعليمية.
42- هل تعمل المنظمة على التركيز على الاستراتيجيات الحكومية في مجال التعليم ومدى ارتباطها بخطة المنظمة، كالاستراتيجيات المتعلقة بتعليم الفتاة، أو الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الأساسي أو التعليم الثانوي، وتلك المتعلقة بالتدريب المهني، وبقية الاستراتيجيات المتوفرة لدى السلطات التعليمية في المجتمع المتضرر، وعلى مستوى أعلى هل تركز المنظمة على إدماج المعايير الدولية المتخصصة في البيئة التعليمية في الطوارئ باعتبار هذه السياسات والاستراتيجيات والمعايير هي البنية التحتية القانونية التي يجب التقيد بها في بيئة التعليم التي تقودها المنظمة في المجتمع المتضرر.
43- هل تركز المنظمة الراغبة بالتدخل في المجتمع على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختياريين أو المعايير الدنيا المتعلقة بتنمية وحماية الطفل وتعليمية، وتلك التي تم تصميمها ليتم العمل عليها في كل مكان يعيش فيه الأطفال مرحلة صراع هو من أساسيات العمل في تعليم الطفل وحمايته وتنميته.
44- هل تعمل المنظمة على تعزيز الأداء العلمي للطفل، وتعزيز النمو البدني والعقلي له، وتنمية الطفولة المبكرة.
45- ما مدى قدرة المنظمة على معالجة الاكتئاب والإجهاد، وتعزيز النجاح، وبناء قدرة الأطفال على بناء علاقات مميزة بعضهم ببعض أو بينهم وبين المجتمع المحيط بهم.
46- هل تعمل المنظمة على الاهتمام بالأطفال اللذين يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة، أو مستبعدون اجتماعيا بسبب طبقتهم الاجتماعية.
47- هل تعمل المنظمة على تعزيز رعاية الوالدين لهم خارج المنظومة التعليمية.
48- هل تعمل المنظمة على تعزيز بيئة وممارسات النظافة والجوانب الصحية المتعلقة بها.
49- هل تعمل المنظمة على تحفيز مهارات الاكتشاف والإبداع العلمي والأدبي لهم، والعمل على أن يصبح التعليم الموجه لهم فعالا ومثمرا.
50- هل تقوم المنظمة بتفعيل الشراكة مع مراكز الرعاية المحلية أو تلك القائمة على المجتمع.
51- هل تعمل المنظمة على بناء القدرات للمعلمين وأولياء الأمور، والعمل على الأنشطة المرتبطة بصحة الطفل كالفحوصات الطبية، والتطعيم، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي.
52- هل تقوم المنظمة بإدماج المهارات التي يحتاجها الأطفال في الصراع كبناء القدرات في الإسعافات الأولية، وطرق التعامل الفضلى مع العمليات الحربية التي تحيط بهم كالقصف، والتعامل مع النيران وإضفاء الطابع المؤسسي للعملية التعليمية ككل لتصبح ذات تأثير إيجابي جيد للأطفال المتضررين.
53- هل تعتمد المنظمة الشمولية في الأداء والشراكات والمناهج والأدوات في التعامل مع الفئات المستفيدة من الخدمة التعليمية في مراحل الصراع، و
54- هل تحترم المنظمة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو أي من الصكوك الدولية المتعلقة بالأطفال فهناك تأكيد على ألا تكون هذه الحقوق مخصصة لفئة دون غيرها من الأطفال ففوائد اتفاقية حقوق الطفل هي موجهة لكل طفل بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الديني أو السياسي أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة أو الوضع الجغرافي كأن يكون لاجئ ونازح أو الوضع الجسدي ويتعلق هذا الوضع بالأطفال ذوي الإعاقة فلا مجال للتمييز في هذه البيئة، ولا مجال لعدم استفادة أي طفل من برامجها.
55- كيف تعمل المنظمة للقفز على أي معوقات تتعلق بالتمييز بين الأطفال في المجتمع المتضرر، واللذين يستفيدون من التدخل الإنساني للمنظمة.
56- ما مدى فهم المنظمة العاملة في مجال الاستجابة الإنسانية لمفهوم التهميش ككل وكيفية معالجته.
57- ما هو المنظور الجنساني للمنظمة في العملية الإنسانية التعليمية.
58- ما هي استراتيجيتها للقفز على الممارسات التمييزية في المجتمع المتضرر؟، والوصول بخدمتها التعليمية الإنسانية لكل طفل.
59- ما الأدوار والمسئوليات المتعلقة بالرجال والنساء في المجتمع؟، وما هي الهياكل والثقافات المجتمعية التي تدعمها؟، وطرق علاجها أو على الأقل ضمان عدم تأثيرها على سير العملية التعليمية في بيئة التعليم.
60- كيف يمكن العمل على الترويج للمساواة وتكافؤ الفرص في محيط الأطفال في المساحة التعليمية الخاصة بهم؟، وضمان استمتاع جميع الأطفال ومنهم الفتيات بالحصول على المساعدة الإنسانية في مجال التعليم ؟، بالإضافة الى الأطفال المعاقين، والذين ينتمون لأقليات عرقية أو دينية أو إثنية، والأيتام، وفاقدي الرعاية الوالدية، والأطفال العاملين، وأطفال الشارع، والنازحين واللاجئين، والأطفال من المقاتلين السابقين والمهمشين والضعفاء وغيرهم من الأطفال المتواجدين في المجتمع المتضرر.
61- هل تعرف المنظمة أعداد النازحين في المنطقة التي ترغب بالتدخل فيها؟، وحالة المدارس في المجتمع المضيف؟، وأعداد الأطفال النازحين؟، ومدى توفر المعلمين؟
62- هل قامت المنظمة بدراسة المدارس المتوفرة في المجتمع واستخداماتها كملاجئ للنازحين أم يمكن استخدامها للعملية التعليمية.
63- من هم الشركاء المحليين اللذين يمكن العمل معهم لتوفير التعليم للأطفال النازحين؟، وكيف يمكن تنفيذ هذا التدخل بسرعة وجودة وشمولية واستدامة.
64- هل تتم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في التدخل الإنساني التعليمي الذي تقوم به المنظمة الأطفال ذوي الإعاقة وهل يتمكنون من الاستفادة من البنية التحية للبيئة التعليمية بشكل متساوي مع الجميع.
65- هل يتم احترام وتفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عدد من الممارسات التي تعينهم على الحصول على الخدمات المخصصة لهم بشكل جيد.
66- هل يوجد معلمين قادرين على إيصال المعلومة والمهارة للأطفال ذوي الاعاقة بشكل جيد من خلال تمتعهم بالتعليم عبر لغة الإشارة للمعاقين السمعيين أو التعليم عبر لغة برايل للمكفوفين أو المعلمين ذوي الخبرة في التعامل مع الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أو من التوحد وغير ذلك من أشكال الإعاقة.
67- هل يتم الاهتمام بمفردة المناهج التعليمية المخصصة للأطفال ذوي الاعاقة ومدى توفرها لهم، والعمل حول ما أسمته الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول.
68- هل تم تطوير البنية التحتية في المساحة الصديقة الخاصة بالطفل لتصبح متلائمة للأطفال ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو غيرهم ممن يعانون أشكال الإعاقة المختلفة.
69- هل تم العمل على زيادة وعي المعلمين والإدارة المدرسية والسلطات التعليمية والأطفال في المساحة الصديقة لهم بطرق التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة حتى لا يتعرضون للعنف أو التمييز أو التنمر من قبل الأطفال أو القائمين على العملية التعليمية.
70- هل تم بناء قدرات المعلمين وسلطات التعليم في طرق التعامل مع الأطفال من هذه الفئة.
71- هل تم العمل على عدم التمييز في سياسات وممارسات التعليم في البيئة التعليمية، ويتم التعامل مع الأطفال من الأقليات أو اللاجئين ممن لا يجيدون اللغة المحلية.
72- هل تم توفير مناهج ومعلمين وسياسات تعليمية تناسبهم وتناهض التمييز ضدهم، واستغلال الأنشطة الأدبية والفنية والرياضية لمساعدة الأطفال على الاندماج.
73- هل تم العمل تيسير إمكانية الوصول الأمن لبيئة التعلم من منازلهم أو المخيمات التي يعيشون فيها الى بيئة التعليم ففي بيئة الصراع غالبا ما يكون الوصول لأماكن تقديم الخدمة الإنسانية هو المعوق لفشل التدخل الإنساني.
74- هل تم تفعيل المشاركة مع المجتمعات المحلية والسلطات التعليمية والأمنية والصحية لإزالة العوائق لوصول الأطفال للمساحة.
75- هل تم العمل على تكوين ممرات أمنة وقصيرة من منازل الأطفال في المجتمع للمساحة الصديقة أو بيئة التعليم المؤقتة.
76- هل تم العمل على علاج المشاكل التي لا يستطيع الطفل من خلالها الوصول للعملية التعليمية.
77- هل توفرت للأطفال مجانية الرسوم الدراسية، والملابس وتوفير الكتب واللوازم المدرسية والتي يمكن أن تقدمها المنظمة النشطة في الاستجابة الإنسانية للتعليم للأطفال.
78- هل تم العمل على توفير التغذية والتي يمكن للمنظمة توفيرها كجزء من تحفيز المجتمع على ذهاب أطفالهم لبيئة التعليم المؤقتة.
79- هل تم العمل على توفير ما يحتاجه بعض الأطفال من ذوي الإعاقة من معينات كالكراسي المتحركة التي تعينهم على الوصول إلى المساحة الصديقة والاستفادة من برامجها المختلفة.
80- وماذا عن التعاون مع منظمات أخرى كتلك التي تعمل في مجال الأمن الغذائي لتقديم المساعدة الغذائية أو النقدية للأسر المتضررة من الصراع ليتسنى للأسرة سحب أطفالهم من العمل أو الشارع وتوجيههم للتعليم والمساحة الصديقة لهم.
81- هل قامت المنظمة بالشراكة مع المؤسسات التي تعمل في مجال المياه والصرف الصحي لتوفير المياه للأسر لتستطيع الفتيات الذهاب للمركز دون المرور بأعمال جلب المياه للأسرة وتوقفها عن التعليم.
82- هل عملت المنظمة على جعل بيئة التعليم والمساحة الصديقة الخاصة بالأطفال وبيئة التعليم المؤقتة تشاركية مع عدد كبير من المنظمات الأخرى المهتمة بواحد أو أكثر من أوجه التدخل الإنساني لتستطيع أن تمنح الأطفال وأهاليهم ميزة الوصول الأمن للمساحة الخاصة بها.
83- هل عملت المنظمة على مناهضة الفساد الذي يستفحل مع انهيار الدولة المركزية والتي ربما تكون فاسدة في الأساس، فغالبا ما تظهر العديد من الجماعات أو السلطات المتحاربة داخل البلد وكل واحدة منها ما زالت تحتاج الأموال التي تساعدها في حربها ضد الجماعات الأخرى أو الدولة المركزية مما قد يجعلها تركز على وضع رسوم عالية على العملية التعليمية المجانية، وهذا يشكل عقبة أمام الأطفال وأهاليهم من الوصول للبيئة التعليمية.
84- هل أدركت المنظمة أن النزاع يودي لقلة أو ندرة إنفاذ القوانين ومنها تلك التي تحظر عمل الأطفال، وزيادة حالات التسرب للفتيات من التعليم بسبب الزواج المبكر، وتلك المتعلقة بالأمان في شوارع المجتمع المتضرر، وتفشي الجريمة أو العنف في المسافة ما بين مجتمعات الأطفال والمساحة الصديقة لهم.
85- هل أدركت المنظمة أن توفر أو عدم توفر النقاط الأمنية ما بين منازل الأطفال والمساحة الخاصة بهم من الجوانب المهمة التي يجب أن تدرسها المنظمة لما لها من دور في إفشال العملية التعليمية ككل.
إن هذه المشاكل تحتاج حلول للوصول لـ:
1- بيئة تعليمية داعمة، مجانية.
2- توفر المناهج والأدوات التعليمية.
3- توفر القوة التدريسية من المعلمين والمعلمات المهنيين والمحترفين.
4- وجود إدارة جيدة للعمل التعليمي.
5- وجود الثقة ما بين المجتمع وسلطات التعليم، وما بينهما وبين المنظمة أو المنظمات المتخصصة.
6- زيادة أنظمة الوقاية، ورصد وتحديد المخاطر المحيطة بالأطفال والعمل على معالجتها لتيسير وصول الأطفال للبيئة التعليمية.
7- تفعيل أنشطة الحماية بداخلها.
8- تمكين الأطفال من الوصول لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
9- تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالأطفال بشكل عادل وشمولي وذو جودة ومستدام.
10- توفر الاستراتيجيات المتعلقة بإعادة الأطفال والمتعلمين ككل للتعليم النظامي.
11- معرفة الطريقة لاستئناف التعليم الرسمي، والممارسات الجيدة لإعادة الأطفال اليه.
12- دراسة والتعرف على احتياجات البلد أو المجتمع المتضرر للعودة للتعليم الرسمي والعمل على تلبيتها.
13- تفعيل الطرق الأجود لاستئناف التعليم بعد الطوارئ، والقادرة على العمل مع المجتمعات التي تعيش مرحلة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، ومساعدتها على التعافي، ومساهمتها بإعادة تأهيل وبناء المدارس.
14- دعم السلطات التعليمية لتصميم ونشر المناهج التعليمية، وإعادة توظيف وإدماج المعلمين، ودعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حملات العودة للمدارس، والمساعدة المادية لتسجيل الأطفال.
15- دعم التنسيق بين شركاء التعليم، والبدء بالعملية التعليمية الرسمية والنظامية، ودعم استمراريتها واستدامتها.
16- المساهمة في حل المشاكل ما بعد الصراع الخاصة بالتعليم والوصول إليه، والدعم المالي والمعلوماتي لتطوير استراتيجياته.
17- دعم الفتيات واللاجئين والنازحين للعودة للمدرسة.
18- تأهيل المدارس الحكومية لتكون ذات حساسية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
19- المساهمة في حل أي عقبات تتعلق بالدمج للمعلمين والمتعلمين والمناهج والسياسات المدرسية والتعليمية في بيئة التعليم النشطة بعد انتهاء الصراع أو حالة الطوارئ التي كان يعيشها المجتمع.
بالنسبة للمساحة الصديقة للطفل فأنه من المهم على المنظمة الراغبة بتفعيل هذا النوع من العمل الإنساني معرفة:
1- كيف يمكنها أن تصنع مساحة صديقة للطفل جيدة وفاعلة ومؤثرة.
2- كيف تساهم المساحة في مجال تعليم وحماية الطفل.
3- كيفية صناعة مساحات آمنة تخلقُ للمجتمعات بيئات تربوية يستطيع الأطفال فيها الوصول إلى لعبٍ حر ومنظَّم، وترفيه، ونشاطات تعليمية.
4- كيف توفر المساحات الدعم التربوي والنفسي والنشاطات الأُخرى التي تُحيي الشعور بالحالة الطبيعية والاستمرارية.
5- هل تم تصميمها وإدارتها بأسلوب تشاركي، وتهدف لدعم الأطفال، ومرونتهم وازدهارهم بعد أن تعرضوا لكوارث.
6- ما مدى مساهمتها في صنع مجتمع منظم ونشاطات منظمة في بيئة آمنة ومحفزة، وتعبئة المجتمعات حول حمايتهم.
7- ما مدى مساهمتها في توفير الفرص للأطفال من أجل اللعب واكتساب مهارات، وتلقي الدعم الاجتماعي، وتقوية رفاتهم، وإدراك حقوقهم، ويمكنها أن تكون آلية لتعبئة المجتمع بما أنه يتم تكييفها مع السياق المحلي.
8- هل تبرز المساحة الصديقة للطفل احتياجات الطفل عن طريق دعم المجتمعات لصالحهم.
9- هل تعمل على إشراك الوالدين أو مقدمي الرعاية بالتفاعل مع قضايا الأطفال، وتُمكينهم في التخطيط والاستجابة والمراقبة والتقييم لنشاطات التعليم.
10- هل عملت المساحة على تقوية الحماية، والتقليل من عوامل الخطر، واستعادة الحياة الطبيعية، والحفاظ على الثقافة والتقاليد للأطفال.
11- هل عملت المساحات في التنمية الجسدية، والاجتماعية، والعاطفية، والذهنية، وتنمية القدرات على التواصل والكلام، وتنمية المهارات، وكيفية التعامل مع الانفعالات، وممارسة اللعب والرياضة كوسيلة للتخلص من الإجهاد والخوف والحزن والفقدان للطفل.
12- هل تقوم المساحة الصديقة للطفل بتفعيل مشاركة الطفل.
13- هل تتميز المساحات الصديقة بأنها محفزة، وتشاركيه، وذات بيئات داعمة، وشاملة.
14- هل المساحة غير قائمة على التمييز، وتركز على سلامة وأمان الطفل.
15- هل تقدم المساحة مساعدات وخدمات عبر التدريب المستمر ومتابعة الدعم للمنشِّطين والموظفين. هل تسهم المساحة في تخفيف الضغط على الأطفال ودعم التنمية الإيجابية لهم، وتوفر الفرص في اللعب، واكتساب المهارات، وتلقي الدعم الاجتماعي، وتعزيز رفاهيتهم.
16- هل أنشطة المساحة متنوعة بحسب الفئات، وتزامن نشاطين في وقت واحد بما يسمح للأطفال أن يختاروا، وتزامن النشاطات للفئات المختلفة منهم.
17- هل تقيم المساحة أحداث للمجتمع بشكل منتظم، وإنشاء نشاطات نمطية، وإجراء نشاطات توعية.
18- هل تعمل المساحة على تقسيم الأطفال لعدة أقسام بحسب أعمارهم وجنسهم ودرجة إعاقتهم، والأخذ بعين الاعتبار هل تستطيع النشاطات معالجة القضايا الشاملة على نجوٍ واسع؟ وهل هي واقعية؟
19- هل تتلاقى أنشطة المساحة مع الاحتياجات المختلفة.
20- هل تسلط أنشطة المساحة الضوء على احتياجات الأطفال والمجتمعات بشكلٍ إجمالي.
21- هل هناك أنشطة للتنسيق مع الوكالات والقطاعات الأخرى لتوفير الدعم لأعمال المساحة.
إن حق كل طفل حتى ولو كان في مجتمع يعيش صراع أن يحظى بتعليم جيد، وشامل، وأمن، يعزز من سعادته، وقدرته على الحب والتفاهم، واحتمال الصراعات من حوله، وموجه لحمايته من أسباب العنف، والإساءة، والإهمال، والاستغلال الجسدي والجنسي، وحاميا له من النزاعات المسلحة، أو المشاركة فيها أو ما يترتب عنها من استغلال الطفل، وحرمانه من حقوقه الأساسية التي يجب أن يتمتع بها في أي مكان وزمان