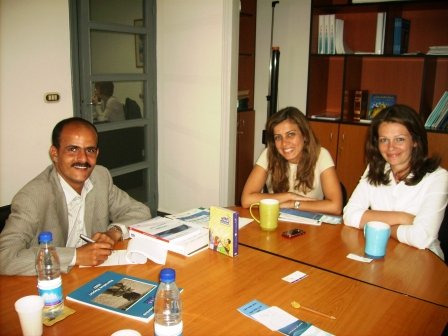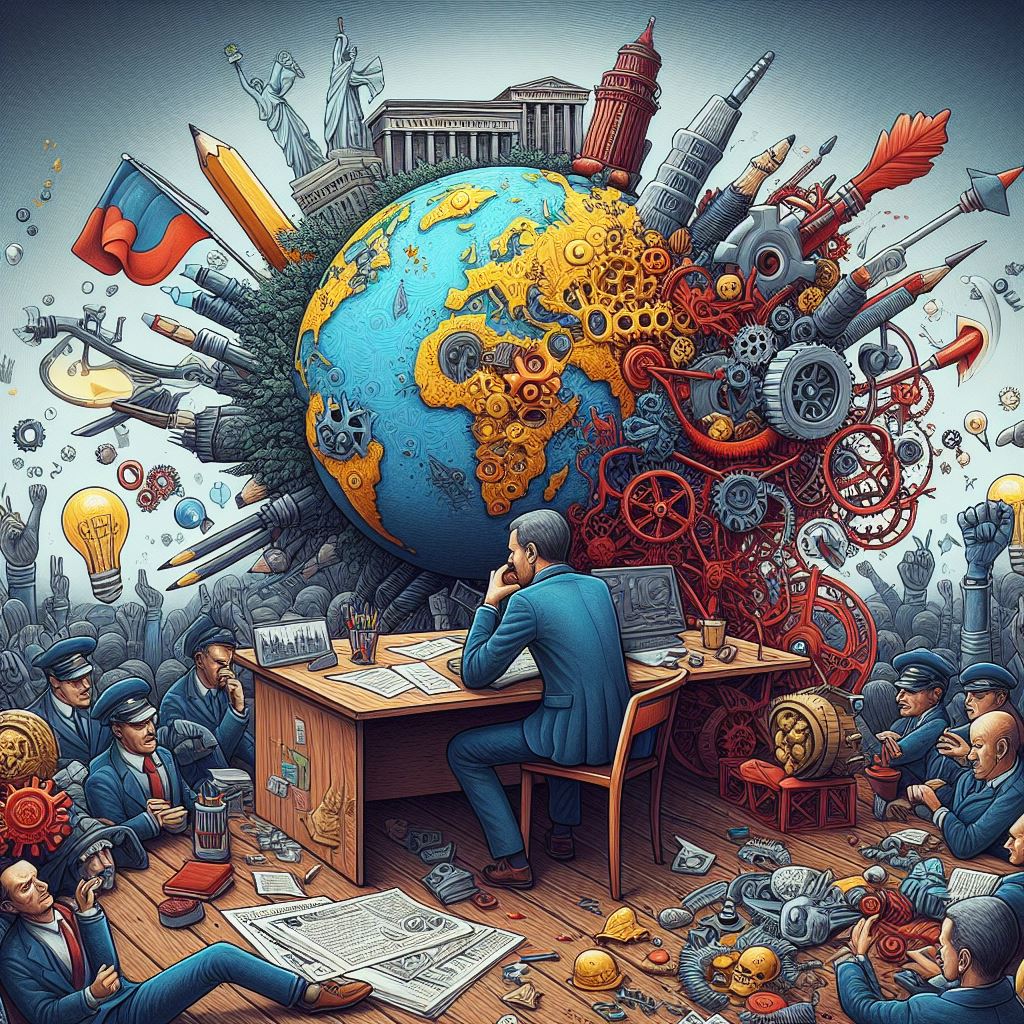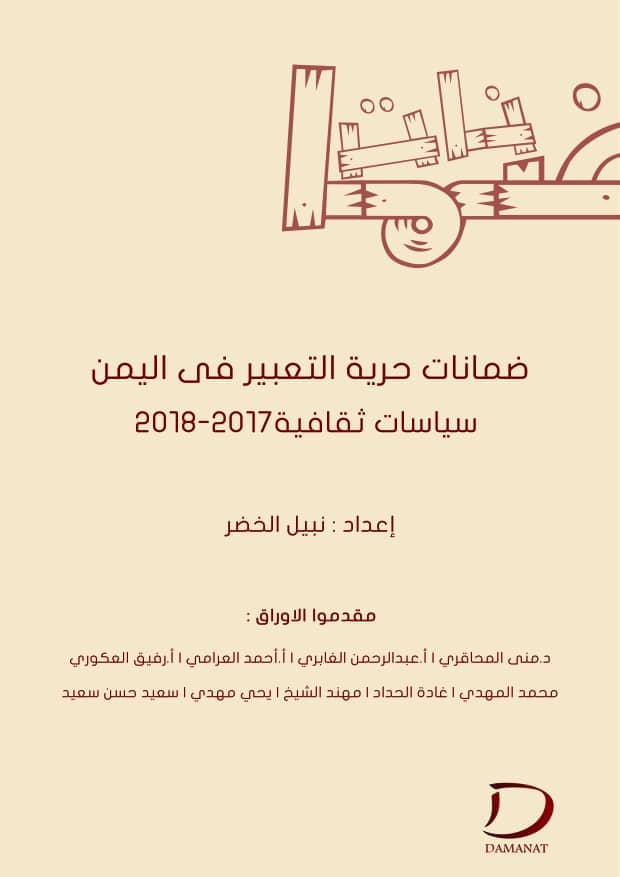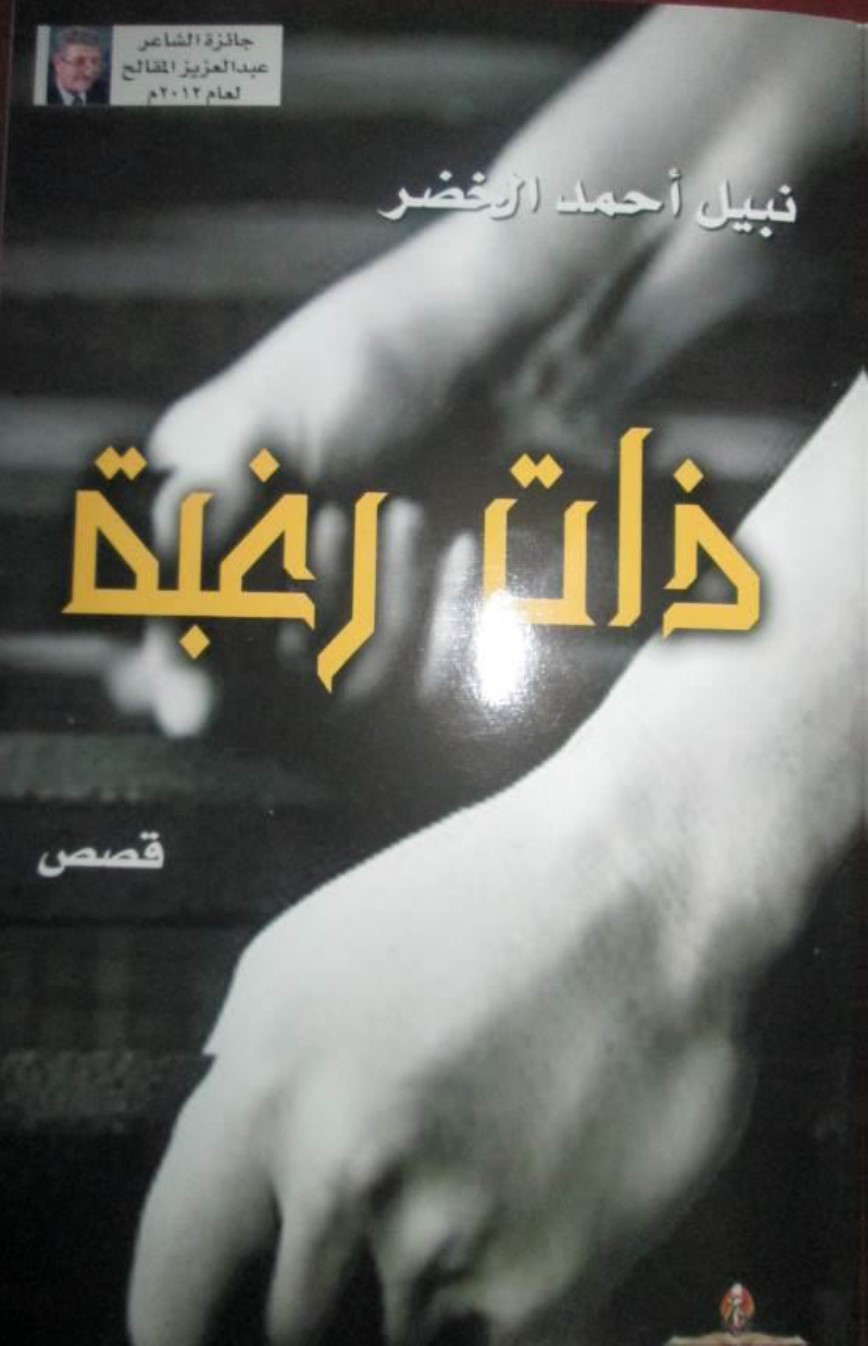Mon,Dec 15 ,2025

أولويات حقوق الطفل في اليمن - حماية الأطفال في الصراعات و التعامل الحكيم مع الأزمات
2025-04-25
الرابع والعشرين:حماية الأطفال في الصراعات و التعامل الحكيم مع الأزمات
يعاني الأطفال كما كل فئات المجتمع من الأزمات السياسية او الحربية أو الأمنية وبالتالي لأجل تحقيق حقوق الطفل العمل على معالجة الآثار النفسية عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح ومعالجة الآثار النفسية عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح، على مستوى الأسرة والمجتمع وتحويل الجمعيات بتنفيذها وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في قطاعات الصحة والتربية والجمعيات الأهلية والمجالس المحلية في منطقة النزاع المسلح حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية نتيجة النزاع وإرسال هؤلاء المتدربين إلى المناطق المتأثرة بالنزاع لتدريب السكان والأسر حول كيفية تقديم الدعم النفسي للأطفال والأشخاص المتأثرين بالنزاع والحالات التي تعاني من صدمات نفسية قوية نتيجة النزاع والحصول على تأهيل وعلاج نفسي أكثر تخصصاً و تنفيذ برنامج الدعم النفسي والتربوي للأطفال وتخفيف آثار الصدمات النفسية عند الأطفال بعد النزاع المسلح وتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وتوفير أماكن للعب وتوفير ألعاب للأطفال حتى يتمتعون بحقهم في اللعب وتنفيذ برنامج ثقافي ورياضي وتوعوي للأطفال والنساء كنوع من الأنشطة الترفيهية والتوعوية.
إن الأطفال في حالات الصراع هم الأكثر تضررا من جميع الفئات الأخرى بسبب من تكوينهم الجسدي أو النفسي أو أعمارهم، ودرجة تأثير الصراع على محيطهم الأمن.
وفي التالي أفكار حول ماهية المخاطر التي تصيب الأطفال في الصراع، وما الذي يمكن عمله في ضوء المعايير الدنيا لحماية الأطفال في الطوارئ، وبحسب المعايير الخاصة بحماية الأطفال في الطوارئ يفترض أن:
1- تستجيب لأي حالة طوارئ غير متوقعة قد تصيب الأطفال وحمايتهم.
2- القيام بعمل خطط، واستراتيجيات، وأنشطة متعلقة بحمايتهم.
3- بناء القدرات في مجال حماية الطفل.
4- التعرف على القضايا الرئيسية ذات الصلة، وتأسيس ممارسات جيدة.
5- إتاحة الفرص لتبادل الخبرات في فهم السياق لحالة الطوارئ وقضايا حماية الطفل الناشئة عنها، وتأثيرها، ونطاقها، والتدخلات لحماية الطفل فيها، والحد من تأثيراتها السلبية.
6- تعزيز المعرفة والقدرات للاستجابة لها، والبرمجة والتخطيط لحماية الطفل فيها بشكل شمولي وجيد.
7- تحسين فهم العوامل التي تجعل من الأطفال عرضة للخطر، وتحسين طرق الاستجابة في الوقاية، والتأهب.
8- تطوير المعارف اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين في حماية الطفل.
9- بناء القدرات للعاملين في مجال حماية الطفل.
10- تطبيق المعايير الدنيا لحماية الطفل والعمل على وضع مبادئ مشتركة بين العاملين في حماية الطفل في الصراع.
11- تقوية التنسيق بين المؤسسات لخدمة حماية الأطفال.
12- ضمان جودة الأنشطة ونجاحها في العمل معهم، وتحسين المسألة في هذه الأنشطة، وتحديد المجالات المهنية المرتبطة بها.
13- توفير ممارسات رشيدة ودروس مستفادة حول حماية الطفل.
14- تحسين المناصرة والتواصل في مجال المخاطر والاحتياجات وماهية الاستجابة التي تحتاجها أنشطة وممارسات حماية الطفل.
ويهتم المبدأ الأول في حماية الطفل بتجنب تعريض الناس للمزيد من الأخطار، والمبدأ الثاني يتعلق بضمان وصول الناس إلى المساعدة دون تحيز، وحمايتهم من الأذى الجسدي والنفسي الناتج عن العنف والإكراه والمبدأ التالي مختص بمساعدة الناس للمطالبة بحقوقهم، والتماس الحلول المتاحة، والتعافي من آثار الانتهاكات، وتقوية أنظمة حماية الطفل، وتقوية قدرات الأطفال على تخطي الظروف الصعبة، والاهتمام بالمبادئ الأربعة الرئيسية في اتفاقية حقوق الطفل الدولية والمتعلقة بالبقاء والتنمية، وعدم التمييز، المصلحة الفضلى للطفل، ومبدأ المشاركة الخاصة بالطفل في جميع أوجه الحياة التي يعيشها.
وتنقسم المعايير الخاصة بحماية الطفل في الصراع لمعايير تهدف لضمان استجابة نوعية لحماية الطفل، وتهتم بالتنسيق، والموارد البشرية، والتواصل، والمناصرة، والإعلام، وإدارة البرنامج، والمعلومات، وإدارة الرصد، وتلبية احتياجات حماية الطفل من المخاطر، والإصابات، والعنف الجسدي، والممارسات المؤذية، والعنف الجنسي، والضائقة النفسية، والاجتماعية، والاضطرابات النفسية، وعمالة الأطفال، والعدالة الخاصة بهم.
ومن ضمن تلك المعايير تلك المختصة بتطوير استراتيجيات ملائمة لحمايتهم، ومنها إدارة الحالات، والآليات المجتمعية، والمساحات الصديقة للأطفال، وحماية الأطفال المستبعدين، ودمج حماية الطفل ضمن القطاعات الأخرى في الاستجابة الإنسانية، ومن ضمنها الإنعاش الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والمأوى، وإدارة المخيمات، وهذه المعايير تتيح للمنظمة الراغبة في العمل في حماية الطفل في الصراع البنية التحتية حول:
1- ما يجب وما لا يجب القيام به في حماية الأطفال في التدخلات الإنسانية.
2- تحدد العاملين والمستخدمين لهذه المعايير، والذين يعملون على تحقيقه.
3- مساعدة المنظمة الراغبة بالتدخل على العمل بجودة، وضمن خارطة عمل مصممة بمهارة لتحقيق أعمالها.
ومن الممكن عبر قراءة هذه المعايير التعرف على من يمارسونها، ويعملون على تحقيقها، من قبيل العاملين في حماية الطفل أو المجالات ذات الصلة بالعمل الإنساني، والأشخاص الذين يعملون مباشرة مع الأطفال والأسر والمجتمعات، والمخططين وصانعي السياسات، والمنسقين العاملين في المشاريع الخاصة بحماية الطفل في المنظمات، والجهات المانحة، والأكاديميين، والأشخاص الذين يعملون في مجال المناصرة، ووسائل الإعلام، والاتصالات، وموظفي الحكومة، والذين يعملون في منظمات مستقلة أو متعددة الأطراف، والذين يعملون في نظام العدالة.
من خلال التعمق في هذه المعايير يمكن التعرف على كيفية استخدامها للتخطيط، وحساب تكلفة التدخلات الإنسانية، وبناء توقعات مشتركة وقابلة للقياس، وبناء اتفاق على مبادئ مشتركة بين مختلف الجهات الفاعلة، ومراقبة وتقييم النوعية والفعالية، وتوجيه وتقييم وتخصيص التمويل، وتجنيد وتدريب موظفين أو شركاء جدد، وتمكين المناصرة بشأن قضايا حماية الطفل، واطلاع صناع القرار، وتمكين العاملين في القطاعات الأخرى من العمل الإنساني لحماية الأطفال بشكل أفضل، وينص تعريف حماية الطفل في الطوارئ على" الوقاية من إساءة المعاملة والاستغلال والإهمال والعنف ضد الأطفال والاستجابة لها وبالتالي فإن حماية الطفل لا تكمن في حماية جميع حقوق الطفل بل تشير إلى مجموعة فرعية منه هذه الحقوق".
ويعتبر التنسيق أول وأهم المعايير في مجال حماية الطفل، ومن أهم الأعمال التي يمكن للمنظمة القيام به لما له من دور في تحسين الاستجابة الإنسانية، وضمان استجابة نوعية أفضل في الوقت المناسب، وبأقل تكلفة.
وينص معيار التنسيق على" تقوم السلطات المعنية والمسئولة، والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو المجموعات السكانية المتضررة بتنسيق جهودهم لحماية الطفل من أجل ضمان أن تكون الاستجابة الإنسانية كاملة وعالية الكفاءة ويكون توقيتها مناسب"، وهذا ما يدعم تقديم الخدمات، والمساعدة على صنع القرار للاستجابة الإنسانية، والتخطيط ووضع الاستراتيجيات، والمناصرة، والرصد وكتابة التقارير، ووضع خطة الطوارئ والاستعداد وبناء القدرات في الأنشطة الخاصة بحماية الطفل ودورة البرنامج الخاص بذلك.
ومن المهم أن تستند جميع برامج حماية الطفل إلى القدرات والموارد والهياكل القائمة، وتعالج المخاطر والاحتياجات الناشئة المتعلقة بحماية الطفل والتي يحددها الفتيان والفتيات والبالغين المتضررون من حالة الطوارئ، وتحليل وتقييم الاحتياجات التي حدثت نتيجة حالة الطوارئ، والتخطيط الاستراتيجي لها وتعبئة الموارد لتلبيتها، وتنفيذها ورصدها ومراجعتها وتقييمها.
وتعتبر عملية الرصد لحماية الطفل في الطوارئ من الأنشطة المحورية بسبب كونها عملية مستمرة وديناميكية وتبدأ بشكل مبكر، وتكون جاهزة للتفعيل حيث ينص المعيار " أن يتم جمع معلومات موضوعية وآنية حول شئون حماية الطفل بطريقة أخلاقية وتستخدم بطريقة منهجية لإطلاق وتوجيه نشاطات الوقاية والاستجابة، وذلك مع أهمية أن تكون المعلومات التي جمعت عبر عملية الرصد أساسية وتقيس التغيير وتستخدم المؤشرات توضح الأثر من التدخل ونتائجه وتسهم في عملية المراجعة والتقييم للتدخل الإنساني في حماية الطفل في الطوارئ، وتعطي معلومات تفصيلية أيضا في ماهية المخاطر والأخطار الجسدية التي يمكن أن تصيب الطفل في الطوارئ.
وعبر المعيار السابق يمكن الدخول في المعيار الحالي والخاص بماهية المخاطر والأخطار الجسدية التي يمكن أن تصيب الأطفال في الطوارئ، والتي إذا لم تتم معالجتها بسرعة وبشكل ملائم ستزيد احتمالية تحول الإصابة لإصابة طويلة الأمد أو دائمة، وخصوصا في الحالات التي تكون فيها الموارد محدودة ويقل احتمال تلقيهم المساعدة الملائمة لعمرهم، ومن أجل كل ذلك ينص المعيار التالي من معايير حماية الأطفال في الطوارئ على أن" يتلقى الفتيات والفتيان الحماية من الأذى و الإصابة والإعاقة الناتجة عن المخاطر الجسدية في بيئتهم وتتم الاستجابة للاحتياجات الجسدية والنفسية الاجتماعية للأطفال المصابين بسرعة وكفاءة ".
إن هذا المعيار ينطوي على مجموعة من الأفكار، والمفاهيم التي تساعد على فهم العنف الجسدي، والممارسات المؤذية الأخرى التي يمكن أن تصيب الطفل في الطوارئ، وما ينطوي عليه من مخاطر، والتعرف على هذه الممارسات المؤذية على النطاق المحلي، والدولي، وإمكانيات وجود فكرة واضحة عن العنف، وأسبابه، وممارساته، وتبريراته، ومن أجل ذلك جاء المعيار في السطور التالية يقوم بتعريف العنف الجسدي الذي يمكن أن يصيب الأطفال في حالات الطوارئ والذي ينص علي " يتلقى الفتيات والفتيان الحماية من العنف والممارسات الأخرى المؤذية ويحظى الناجون باستجابات ملائمة لعمرهم وثقافتهم ".
أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو من أنواع العنف المنتشرة بقوة في الصراع، وبالتالي يمكن العمل على كيفية منع ومواجهة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وقد تم التركيز على هذا النوع من العنف في المعيار التالي والذي ينص أن" تتم حماية الفتيات والفتيان من العنف الجنسي ويزود الناجون من العنف الجنسي بمعلومات ملائمة لأعمارهم إلى جانب الاستجابة الآمنة والسريعة والشمولية "، ويقصد بالعنف الجنسي أي فعل جنسي غير مرغوب به، والتحرش الجنسي، والاغتصاب والدعارة، والاستغلال الجنسي، والذي يعتمد على ديناميكيات القوة بين الطرفين، ويقع في الغالب على الفتيات والفتيان الصغار، والمراهقين، والأطفال المنفصلين عن ذويهم، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين لجماعات أو قوات مسلحة، والنازحين، واللاجئين، و المنفصلين عن أسرهم كأطفال الشوارع، والأطفال العاملين، ويزيد العنف الجنسي في الصراع بسبب:
1- استخدامه كسلاح من أسلحة الحرب، أو بسبب وجود جماعات وقوات مسلحة في محيط الأطفال.
2- وجود أعداد كبيرة من الرجال الأغراب أو رجال دون عائلاتهم في المجتمع أو مخيم النازحين.
3- بسبب تشريد الأطفال والسكان من مجتمعاتهم المحلية، ووضع الأطفال وانفصالهم عن أسرهم، وبسبب الفقر.
4- نقص الخدمات الأساسية والغذاء، وانتشار الاتجار بالبشر التي تزيد في أوضاع الصراع، أو بسبب انتشار الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في المجتمع.
5- تدني أو ضعف تصميم إدارة المخيم الذي يعيش فيه الأطفال النازحين أو اللاجئين.
6- عدم وجود أنظمة أمنية فعالة من قبل الشرطة أو أفراد الأمن أو لجان الأمن الشعبية.
7- غياب قوة القانون في مراحل الصراع في الغالب، وقدرة الدولة التي تعيش الصراع على مسألة الجناة وخصوصا إن كانوا لا يعيشون ضمن الأراضي التي تحكمها.
وقد تعزز حالات العنف الجنسي بعض العادات والتقاليد المجتمعية المنتشرة كالزواج المبكر، والزواج القسري، وإعطاء الزوج صلاحيات غير محدودة في التعامل مع زوجته مما يعزز الاغتصاب الزوجي، وافتقار النساء لـ بطاقة إثبات الهوية، وغياب دور المرأة في الشرطة، وإدارة المخيمات، وتوزيع المساعدات، ومن خلال المشاكل التي تم الحديث عنها.
ويمكن الحديث عن الحلول لها من خلال:
1- ضمان توفير الخدمات للنساء والأطفال بطريقة تحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل المدارس القريبة من المناطق السكانية، ونساء يقمن بتقديم الخدمات.
2- تصميم ووضع المخيمات بطريقة تقلل احتمالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الإضاءة في المراحيض.
3- العمل على تغيير المعايير الاجتماعية التي تدعم العنف مثل التمييز ضد الفتيات، والزواج المبكر، ووجود نساء في وحدات الشرطة المجتمعية، وكسر جدار الصمت حول العنف الأسري.
4- العمل على محاسبة الجناة، وتقوية أنظمة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتقوية آليات وأنظمة المعالجة لتخطى هذه الظروف معيار مهم من معايير حماية الأطفال في الطوارئ.
وينص هذا المعيار أن " تتم تقوية آليات التدبر والقدرة على تخطي الظروف الصعبة لدى الفتيات والفتيان ويحصل الأطفال المتضررين بشكل خطير على الدعم الملائم"، ويقصد المعيار أن يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ومعالجة السلامة الجسدية، والفكرية، والعاطفية، وأن تكون مناسبة مع العمر ويدعم تنمية علاقات اجتماعية إيجابية، وأن يكون للأشخاص إمكانية الوصول للموارد الاقتصادية والبيئية.
وهناك الكثير من الأدلة التي يمكن من خلالها لمن يعمل مع الأطفال التعرف على إصابتهم بالعنف الجسدي أو الجنسي ليستطيع التصدي لها بفعالية، ومن ردود الفعل الجسدية:
1- ضربات قوية للقلب، وتوتر العضلات، وضيق التنفس، وألم بدون سبب مثل الصداع، والدوخة، وتشنجات العضلات، والتعب، وفقدان الطاقة.
2- تغييرات في التفكير مثل التفكير فقط في المشكلة، والارتباك، وتغييرات المزاج بسهولة، وصعوبة التركيز، وتذكر الماضي.
3- عدم القدرة على الوثوق بالآخرين، وتغييرات في المشاعر مثل الشعور بالغضب والحزن أو اليأس، وعدم الشعور بشيء، وتغيرات في المزاج غير منتظمة.
4- عدم التعاطف مع الآخرين.
5- تغيرات سلوكية مثل مشاكل في الأكل والنوم، وانسحاب أو عدوانية مفرطة وعصبية، ومستويات عالية من الخوف والقلق، وزيادة في الاتكالية، والدعم من الآخرين.
6- الانخراط في الأنشطة الخطرة، وهذا ما يدعو العامل في مجال حماية الأطفال في الطوارئ إلى العمل على أساسيات الدعم النفسي لمعالجة العنف الذي أصيب به الطفل.
وهناك العديد من آليات الاستجابة الإنسانية من قبيل:
1- إعادة الاتصال بين الأطفال وأفراد الأسرة والأصدقاء والجيران.
2- تشجيع الصلات والتفاعلات الاجتماعية.
3- إضفاء طابع الاعتيادية على الحياة اليومية.
4- تعزيز الشعور بالكفاءة والسيطرة على حياة الفرد.
5- تعزيز المرونة، وتقوية قدرة الأطفال على تخطي الظروف الصعبة؟
6- زيادة احترام كرامة الأطفال، والقائمين على رعايتهم، والمجتمع.
7- تشجيع اللعب المنظم، والأنشطة الترفيهية، وإعادة بناء الأنشطة المدرسية.
8- متابعة الأنشطة والتقاليد الثقافية، والعودة لروتين العمل العادية.
9- تعزيز تقديم المعونة.
10- تشجيع الطرق الفردية والجماعية لتخفيف التوتر.
إن وجود الصراع يرتبط ارتباط وثيق بعمالة الأطفال، ووجود أطفال الشارع، والأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، والأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، وفي هذه الفئة الأخيرة يهتم المعيار القادم بحمايتهم حيث ينص أن " تتم حماية الفتيات والفتيان من التجنيد والاستخدام في الأعمال العدائية من قبل القوات أو الجماعات المسلحة ويتم تحريرهم وتزويدهم بخدمات الدمج الفعالة"، ويستخدم الأطفال في مثل هذه القوات أو الجماعات المسلحة كـ حمالين أو طهاة أو جواسيس أو استخدامهم شراك خداعية أو كعبيد للممارسة الجنسية.
في هذا الجانب والمتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات فقد تم تحديد هذا الجانب بتعريفات مهمة وأهمها هذا التعريف الذي ينص أن "أي شخص دون سن 18 سنة يكون جزء من أي نوع من أنواع القوة المسلحة النظامية أو غير النظامية أو مجموعة مسلحة بأي صفة، بما في ذلك على سبيل المثال الطهاة. الحمالين. الرسل. وأي شخص يرافق مثل هذه الجماعات وغيرها من أفراد الأسرة".
ويشمل التعريف تجنيد الفتيات لأغراض جنسية والزواج القسري، وينظم الأطفال لهذه القوات بسبب الأجر المالي، ووعود بحياة أفضل، أو لأجل الانتقام، وبسبب الفخر أو الشرف بالانضمام إليها، وترغب هذه القوات بالأطفال لأنه من السهل غسل أدمغتهم وإكراههم على العمل.
وقد اهتمت المعايير الدنيا لحماية الأطفال في الصراع بهذه الفئة من الأطفال من خلال هذا المعيار الذي ينص أن " تتم الوقاية والاستجابة للانفصال عن الأسرة ويحصل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على الرعاية والحماية وفقا لاحتياجاتهم الخاصة ومصالحهم الفضلى"، وفسرت العديد من الأبحاث الانفصال فقد ذكرت أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم هم المفصولين عن كلا الوالدين، وغيرهم من الأقارب، ولا يتلقون الرعاية من قبل الكبار المسؤولين عن رعايتهم بحكم القانون أو العرف، والذين انفصلوا عن كلا الأبوين، أو مقدمي الرعاية القانونية أو العرفية الأولية، ولكن ليس بالضرورة من أقارب آخرين. وبالتالي تشمل هذه الأطفال المرافقين لأفراد الأسرة الكبار الآخرين، وهم أيضا الأيتام، والأطفال في الأسر التي يرأسها أطفال، والأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويعيشون مع مجموعة من الأطفال الآخرين.
إن أسباب الانفصال كثيرة ومتنوعة في حالات الصراع ومنها:
1- ضياع الأطفال في فوضى الهجوم.
2- وفاة الوالدين أو مقدمي الرعاية.
3- عندما يكون الأطفال بعيدين في المدارس، والمستشفيات.
4- عندما تضطر العائلة للفرار.
5- الاختطاف، أو القبض أو احتجاز الوالدين أو مقدمي الرعاية.
6- أن يشرد الأطفال من دون آبائهم وأوليائهم.
7- وضع الأطفال في دور الأيتام أو المؤسسات من قبل الآباء على أمل تقديم خدمات أفضل لهم.
8- قرار الأطفال الهرب لسوء المعاملة، أو للعمل، أو انضمامهم للقوات المسلحة.
9- مغادرة الوالدان لمنطقة أو بلد آخر للعمل.
10- إجلاء الأطفال لأسباب طبية أو بسبب الإغاثة والمساعدات التي تقدم بطريقة قد تعزز الانفصال الأسري، والاتجار.
وينقسم الانفصال لأشكال متعددة، ومنها:
1- الانفصال الرئيسي والذي يحدث كنتيجة مباشرة وفورية لحالة الطوارئ ك قتل الآباء أو انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء القتال.
2- الانفصال الثانوي والذي يحدث نتيجة للتأثيرات الأخرى لحالة الطوارئ مثل الفقر، وعواقب الانفصال وخيمة، وتلقي بظلالها على الطفل وحياته ومستقبله، ومنها إهمال، وإساءة المعاملة الجسدية، والعاطفية، والاستغلال الجنسي، والتجنيد العسكري، والاعتقال التعسفي، والاتجار، والتمييز والحرمان من الحصول على الطعام، والمأوى، والسكن، والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم وجود البيئة الأسرية والرعاية المستمرة، والتي من دونها يكون نموهم الكامل عرضة للخلل، والإصابة بالمرض.
وهناك العديد من الإجراءات والتي يمكنها حماية الأطفال من الانفصال عن ذويهم من قبيل:
1- استخدام حملات الاتصال الجماهيرية مع المدرسين والعاملين في الصحة، وغيرهم.
2- توفير معلومات إلى الوالدين ومقدمي الرعاية حول مخاطر وضع الأطفال في المؤسسات البديلة، وبدائل الرعاية الأسرية.
3- وضع أساور للتعريف بالهوية على معصم الأطفال.
4- تعليم الأطفال وكبار السن قول أسمائهم وأسماء والديهم، وتعليم الأخوة الأكبر سنا رعاية إخوتهم الصغار.
5- تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الضعيفة لمنع الانفصال.
6- الانتباه لآليات الإحالة وأماكن الذهاب للآباء والأمهات الذين فقدوا الأطفال.
7- تسجيل الأطفال قبل الإيواء، وأخذ تفاصيل عن جميع الأطفال المقيمين تحت الرعاية في المستشفى.
8- تعزيز الإجراءات الحكومية، وتوفير معلومات عن الإطار القانوني للرعاية البديلة.
9- وضع سياسة بشأن الأطفال المنفصلين من أجل تعزيز الرعاية الأسرية وتثبيط الطابع المؤسسي.
10- حظر تبني الأطفال المتضررين حتى سنتين على الأقل من بعد حالات الطوارئ.
11- حظر حركة الأطفال خارج البلد دون الأوصياء القانونيين.
12- القيام بحملات ضد الانفصال الأسري. والنظر في استخدام برامج التحويلات النقدية والسياسة والاجتماعية لمنع الانفصال. وإنشاء آليات لرصد الأسر المعرضة لخطر الانفصال
إن حماية الطفل هو أولوية ملحة، ونشاط ذو أهمية فارقة في العمل الإنساني، ويجب أن يحظى بالدعم والرعاية والتفعيل وتحقيق جميع أهدافه لكل طفل يعيش محنة الصراع.
وينتشر العنف في المجتمعات الحديثة بشكل كبير نتيجة عدة عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وكذا دور وسائل الإعلام وصناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية في العالم في هذا الجانب، وفي موضوع العنف ضد الأطفال فما يزال منتشر في الكثير من المجتمعات برغم مناهضتها ووجود قوانين تعمد إلى حظر ممارسة العنف ضد الأطفال في الكثير من الدول، وفي جانب العنف عموما والعنف ضد الأطفال تحديدا فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية تعريفها عنه بأنه الاستخدام المتعمد للقوة أو السلطة، أو التهديد بذلك، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو عدد من الأشخاص أو مجتمع بأكمله، مما يترتب عليه، أو قد يترتب عليه، أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو حرمان.
ومن ناحية أخرى فقد اشتملت اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها العديد من أشكال العنف الذي يصيب الأطفال ودعا إلى إنهائها من قبيل جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي، والإهمال المتعمد أو المعاملة السيئة أو الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالأطفال. أو العنف الذي يكون مصدره القائمين على رعاية الطفل أو المسؤولين عنه، ويشتمل على العنف البدني، والعنف النفسي، والتمييز، والإهمال، وسوء المعاملة، ويتراوح من الإيذاء الجنسي في نطاق البيت إلى العقاب البدني والمهين في المدرسة، ومن الإيذاء والإهمال في المؤسسات إلى الاشتباكات بين عصابات الصبية في الشوارع التي يعمل بها الأطفال أو يلعبون، ومن قتل الأطفال إلى ما يطلق عليه القتل دفاعاً عن الشرف.
في الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل تم تعريف الطفل بأنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وفي المواضيع المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال يفترض العمل على إجابات عديدة منها ما هو أسري ومنها ما هو مجتمعي ومنها ما هو حكومي وأخرى سياسية والبعض منها مؤسسي وحتى الوصول إلى المستوى الدولي.
وفي هذه السطور سنبدأ بطرح الأسئلة ثم نحاول الوصول إلى إجابات للوصول الى أسباب العنف ضد الأطفال والإجابات الخاصة بها ومحاولة الوصول الى حلول لهذه القضية العويصة والمنتشرة في كل المجتمعات الإنسانية برغم لا إنسانيتها في الأساس فالعنف ضد الأطفال يفترض أن يكون غير مقبول في جميع المجتمعات وفي كل السياقات المعيشية وعلى جميع الأصعدة.
في مجال الأسئلة سنبدأ بالحكومات وطرح الأسئلة عن مدى التزامها بمواضيع حظر العنف ضد الأطفال في البيت أو الشارع أو المدرسة أو في أي مكان يعيش فيه الطفل.
وقد حددت بعض القوانين الوطنية في بعض الدول العنف ضد الأطفال كتصرف غير مقبول ويعاقب عليه وعلى الصعيد الدولي حددت الاتفاقيات الحقوقية موقفها المعارض تماما للعنف ضد الأطفال ونذكر من هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا بالإضافة الى الدراسات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات المتلاحقة لمناهضة العنف ضد الأطفال من قبيل دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، والتوصيات المتضمنة في التقرير العربي المقارن الأول 2010.
إن الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن بالنسبة للدول يجب أن تبحث في الالتزام الدولي للدولة أمام العالم بإعطاء حظر العنف ضد الأطفال أولوية من ناحية الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتخصصة في هذا الجانب، وهل صادقت الدولة على الاتفاقية والبروتوكولات، وفي حال مصادقتها هل بدأت العمل على الأرض في تفعيل العمل بهذه الاتفاقيات في مؤسساتها وشوارعها ومجتمعاتها أم لا، وما هي الخطوات التي حققتها الدولة لتنفيذ مواد وتوصيات هذه الاتفاقيات والبروتوكولات والدراسات والتوصيات، وهل كانت لدى الدولة ولتكن هنا اليمن تحفظات على أي مواد من تلكم الصكوك الدولية أو الإقليمية وهل قامت بسحبها أم لا.
ومن ناحية أخرى فيمكن طرح الأسئلة عن المجتمع المدني في الدولة وهل قامت تلك المؤسسات الغير حكومية بالتوعية بحقوق الطفل والضغط لأجل تطبيق مواد الاتفاقيات والعمل على وضع التقارير الخاصة بتطبيق حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال في الدولة أم لا، وهل ساهمت في وضع التقارير الخاصة بالعنف ضد الأطفال وساهمت مع الدولة في التحضير لهذه التقارير وتقديمها في مواعيد استحقاقها للجنة الخاصة بذلك ومدى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الدولة في وضع التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الطفل أو بالعنف ضد الأطفال، وكذا مدى مشاركة تلك المؤسسات الغير حكومية والدولة نفسها في تحفيز الأطفال على المشاركة في صياغة وتحضير تلك التقارير.
وفي الجانب المتعلق لمرحلة ما بعد تقديم التقارير وتسلم الملاحظات الخاصة باللجنة الدولية لحقوق الطفل فما هو دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في المجتمع المحلي في الدولة في وضع الإجراءات وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع لتنفيذ ملاحظات اللجنة، و التدابير التي اتخذت لإعمال تلك التوصيات والتعليقات والملاحظات على أرض الواقع من توعية وتدريب وبناء قدرات ووقاية ورصد وتوثيق وإحالة وعلاج وتطوير قوانين وغير ذلك من التحركات مع العمل على توفير الدعم الوطني والإقليمي والدولي بما يضم الدعم المالي والسياسي والمجتمعي للتنفيذ.
وبعد العمل على الجانب الدولي وتعامل الدولة مع الاتفاقيات والصكوك الدولية يمكن النظر في العديد من الأسئلة التي ما زالت تبحث عن إجابات على النطاق الوطني وأول تلك الأسئلة تتعلق بالجانب التشريعي والقانوني كأول مدخل من مداخل مناهضة العنف ضد الأطفال وبما يساهم في تشجيع العاملين في هذا المجال من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على تطبيق حماية الأطفال من العنف في جميع الحالات وفي كل المؤسسات في الدولة.
وبالتالي يمكن وضع الأسئلة حول هل اشتملت التشريعات الوطنية بشكل واضح على حظر كافة أشكال العنف ضد الأطفال وفي مختلف أماكن تواجدهم سواء في المنزل أو المدرسة أو مكان العمل أو المؤسسات الغير حكومية التي تعمل مع الأطفال أو في المؤسسات الايوائية والرعائية والعقابية وهل أدرك كل العاملين مع الأطفال والمحيطين بهم أن هذه القوانين ملزمة وواضحة ويجب تطبيقها في التعامل مع الأطفال أم لا، وكذا هل يعرف الأطفال والعاملين معهم في كل مكان أن التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال ضرورية لتقليل حالات العنف ضد الأطفال حتى النهاية.
وبالنسبة لمؤسسات الدولة فإن المدارس هي المؤسسات الأهم والتي تستوعب أغلب الأطفال بداخلها ضمن العملية التعليمية وهي المؤسسات التي ما زالت تستخدم العقاب البدني في الكثير من الدول كجزء من التأديب رغم مساوئ هذا الشكل من أشكال العنف ضد الأطفال.
وبالتالي يجب الأسئلة حول هل هناك قوانين وطنية واضحة ومحددة تمنع العنف في المدارس على أنواعه، وهل هنا توعية للعاملين مع الأطفال في المدارس حول الإطار القانوني لحظر العنف في هذه المؤسسات، وهل هناك فهم لدى أولئك العاملين أن حماية الأطفال من العنف في المدارس يشمل الوقاية، وحماية الضحايا، والتعافي، وعقاب المعتدي، وهل يفهم العاملين مع الأطفال ضمن العملية التعليمية أن حظر العنف في المدارس يشمل العقاب البدني، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، والتنمر، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحظر العقوبة البدنية على الأطفال في العملية التعليمية بكافة قطاعاتها الحكومية أو الخاصة.
وفي الجانب المتعلق بالجزء العملي في حماية الأطفال من العنف في العملية التعليمية أو في المدارس العامة أو الخاصة فيمكن طرح العديد من الأسئلة التي تتعلق بمدى تنفيذ إجراءات وممارسات حماية الأطفال من العنف من قبيل هل تتوافر آليات لرصد العنف في المدارس، وما هي هذه الآليات، ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية الرصد؟ وما هي آلية عملها؟ وما هو الاطار القانوني الذي ينظمها، وما هي الآليات الامنة والحساسة للطفل المتاحة للأطفال في المدارس، ومدى تواجد اليات الشكاوي حول قضايا العنف ضد الأطفال في المدارس على جميع النطاقات المحلية والوطنية، وهل هناك نظام لتوثيق البلاغات والشكاوى ضمن المدرسة، ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية التوثيق، وهل هي متاحة للجمهور، وكيف يستفيد منها، وهل هي مرتبطة بقاعدة بيانات على المستوى الوطني، و كيف يتم التنسيق مع آليات الابلاغ الاخرى المتوفرة على المستوى الوطني، وما هي الجهود التي تبذلها الدولة او الجهات المسؤولة عن الآليات المتوفرة للشكاوى والابلاغ لتعريف الأطفال بوجود هذه الآليات وتشجيعهم على استخدامها، وهل توجد مبادرات تقوم بها الدولة او المدارس لاعتماد وتنفيذ مدونات السلوك للمدرسين والعاملين في المدارس في القطاعين الرسمي والخاص، وهل يلحظ نظام توظيف المدرسين و العاملين حماية الأطفال من العنف في المدارس، وهل لديهم القدرة والتدريب اللازمين للاستجابة والوقاية من العنف ضد الطفل، وهل توجد سياسة لحماية الطفل في المدرسة الرسمية او الخاصة، وما هي الاجراءات التي تتخذونها لاعتماد سياسة لحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، وهل يشتمل الاطار القانوني لحظر العنف في المدارس على دور للجان الأهل وكيف يتم تفعيل هذا الدور للمساهمة في تخفيف حالات العنف ضد الأطفال ضمن المؤسسات التعليمية.
ويزداد العنف ضد الأطفال في مراحل النزاعات والحروب وحالات الطوارئ التي تمر بها بعض الدول كما حدث في الدول التي مرت بمرحلة الربيع العربي في العالم العربي 2011 حيث دخلت بعضها مرحلة نزاع مرير ومستمر كان له تأثير كبير على تفشي العنف ضد الأطفال بما في ذلك حالات العنف الجسيمة والمنتشرة على نطاق واسع.
في هذه الحالات يفترض بالدول التي تمر بحالات النزاع أو الحروب والطوارئ العمل بجدية على تحديد الخطط ورفع مستوى جاهزيتها لحماية الطفل من العنف في هذه المراحل الزمنية والوطنية المربكة والخطيرة والعمل على تطوير وتطبيق القوانين والآليات الوطنية والمحلية التي تعمل على حماية الأطفال في هذه الأزمات ونتائجها الخطيرة مثل اللجوء والنزوح والعنف المسلح والاضطرابات السياسية والأمنية، ومعرفة هل هذه الآليات مرتبطة بنظام حماية وطني وفعال.
إن من المهم معرفة كيف يمكن حماية الطفل رغم الصعوبات والتحديات التي يمكنها أن تعرقل هذا العمل بسبب الحرب أو الازمة السياسية في الدول، وهل القوانين، والإجراءات، والتدابير التي تعتمدها الدولة لوقاية وحماية الأطفال أثناء الطوارئ تشمل كل الأطفال دون أي تمييز، وكذا العمل على معرفة ما هي التشريعات التي تمنع استخدام وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
ومن المهم أيضا التعرف على الخدمات التي تتوفر للأطفال في مرحلة النزاعات والتأكد من أن جميع هذه الخدمات متاحة حسب القانون والممارسة لجميع الأطفال دون أي تمييز مثل الإبلاغ والشكوى، الخدمات التعليمية والصحية، إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، والتأكد من وجود آليات رصد ومتابعة العنف ضد الأطفال في حالات الطوارئ، ومساهمة الجميع بما في ذلك المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني الجهود التي تبذلها الدولة لضمان مشاركة الأطفال في تحليل أوضاعهم وتقديم مقترحاتهم أثناء حالة الطوارئ وما بعدها.